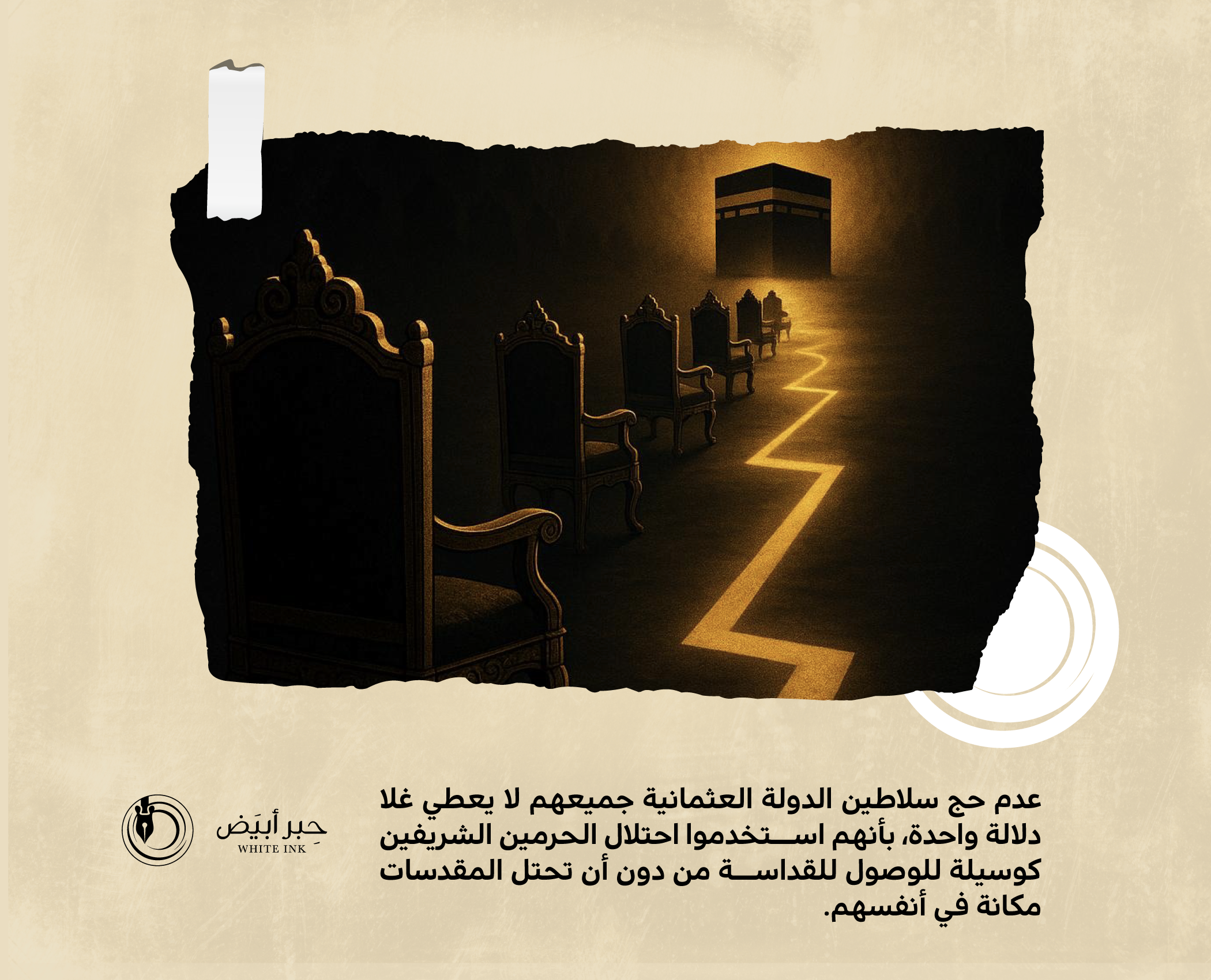الحج والسياسية
لدى سلاطين الدولة العثمانية
منذ فجر الإسلام ارتبطت مكانة الحاكم بشرعية أدائه للشعائر الكبرى، وعلى رأسها الحج إلى بيت الله الحرام، غير أنّ السلاطين العثمانيين تفرّدوا بترك هذه الفريضة رغم قدرتهم، مكتفين بإظهار عناية سياسية بالحرمين دون ممارسة فعلية للشعيرة, فما الذي دفع السلاطين العثمانيين إلى تجنّب الحج إلى مكة المكرمة؟ وما الذي دفع أكثر من ستة وثلاثين سلطانًا إلى عدم أداء أحد أركان الإسلام الخمسة مع قدرتهم واستطاعتهم على الحج؟ خاصةً وأن الخلفاء العرب حجّوا قبلهم إلى مكة، ولم يُمنع منهم أحد. بل لقد كان الحج أُمنية الأماني لعامة المسلمين وتجارهم وحكامهم، يبذلون الغالي والنفيس في سبيله.
سليمان القانوني قدَّم ضريحه على الكعبة المشرفة

يقول كمال كاربات في كتابه تسييس الإسلام: إعادة بناء الهوية والدولة والدين والأمة في الدولة العثمانية: “وكما هو حال بقية السلاطين العثمانيين، لم يؤدِّ عبدالحميد فريضة الحج مطلقًا مع كونها فريضة مرة على الأقل في العمر لمن استطاع إليها سبيلًا، بيد أنه انضم إلى اثنتين من الأخويات الصوفية الشعبية.. إلا أنه لم ينضم إلى النخبة المولوية التي حبّذ كثيرون من أسلافه وأخيه مراد الانتماء إليها”.
فهل أعطت الطرق الصوفية السلاطين رخصةً لترك الحج؟ خاصة وأن بعض الطرق تسقط العبادات عن معتنقيها، وتجعلهم في طبقة أعلى من البشر كما يدّعون. وهو أمر ليس بالجديد، إذ كثير من الطرق منحت قادتها أو بعض مقلديها المخلصين تلك الرخصة، ولا شك أن الحج كان منها. ولأن السلاطين العثمانيين كانوا من أكثر المؤيدين للطرق الصوفية، وخاصةً المتطرفة منها مثل البكتاشية وغيرها، فمن غير المستبعد أن يكون ذلك جزءًا من مبرراتهم لعدم الحج.
أما ما يُدعى من حرص السلاطين العثمانيين على الحرمين الشريفين، وانطلاقًا من مكانتهما في الشعائر الإسلامية، كقبلة للصلاة ومقصد للحج، فقد كان حرصًا سياسيًا فقط، لإضفاء الشرعية على احتلالهم للبلاد الإسلامية بعد إسقاطهم للخلافة العباسية في مصر، والتي كانت مظلةً لحكم المماليك. خاصةً أنه لم تكن لهم ميزة تمنحهم حق حكم الحرمين الشريفين وسائر الشعوب الإسلامية.
ومن هنا يثور سؤال آخر: هل أراد العثمانيون تحويل القبلة من مكة المكرمة إلى إسطنبول؟ وإلا فلماذا قام السلطان سليمان القانوني بالاستيلاء على الأحجار القليلة المتبقية من الحجر الأسود ونقلها إلى إسطنبول؟ خصوصًا أن من المعلوم أن الحجر الأسود، وبسبب اعتداءات البغاة من أمثال “القرامطة”، كان هدفًا لمحاولات نقل التعبّد من الكعبة ومكة المكرمة إلى أماكن أخرى.
لقد استخدم السلطان سليمان القانوني نفوذه وسلطته ليستحوذ على ما تبقى من الحجر الأسود، مفضّلًا إسطنبول على مكة، وضريحه على الكعبة المشرفة. وقد جرى توزيع تلك القطع، فوُضِع بعضها في جامع “صقلي محمد باشا” في إسطنبول؛ إذ كانت القطع التي نُزعت من الحجر الأسود عدة شظايا. جرى تثبيت أربع منها على المحراب والمنبر والقبة وعند الباب، بينما وُضعت القطعة الخامسة والأكبر فوق ضريح السلطان سليمان القانوني.
يذكر علي السنجاري في كتابه منائح الكرم أن السلطان مراد الرابع سنة (١٠٤٠ه) أرسل المعماري التركي رضوان لإصلاح ما تهدّم من الكعبة المشرفة بعد أن تعرضت لأضرار. وحين وصل المعماري إلى الكعبة وجد الحجر الأسود قد تشظى إلى عدة قطع، وتفككت أجزاؤه، بحيث كان بإمكان أي أحد أن يأخذ منها ما يشاء. ولعل هذا السؤال تدعمه حقيقة أنه لم يكن هناك خطر يتهدد الكعبة أو الحجر الأسود في عهد السلطان سليمان القانوني، مما يرجّح أن الأنانية وتفضيل الذات، أو النظر إلى الكعبة باعتبارها من ممتلكاتهم الخاصة، قد يفسّر ذلك السلوك.
بل إن الموقف من الحج انتقل من السلاطين إلى الأمراء الأقل رتبة في هرم الحكم العثماني. إذ يقول منير أطالار في كتابه الصرة الهمايونية ومواكب الصرة: “لم يذهب أحد من السلاطين العثمانيين قط لأداء فريضة الحج، حتى السلطان سليم الأول – الذي فتح مصر – لم يذهب للحج، بالرغم من قربه من الديار المقدسة. أما بقية الأمراء فلم يحج أحد منهم سوى الأمير (جم). أما بقية الأمراء، فلم يُعرف أن أحدًا منهم قد حج”.
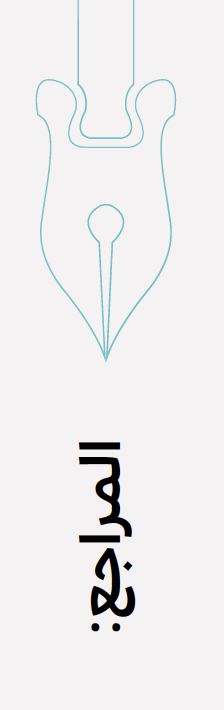
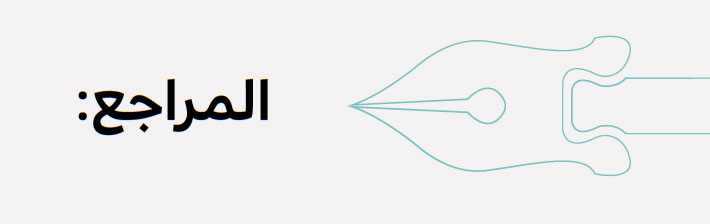
- علي السنجاري، منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم (مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 1998).
- منير أطالار، الصُّرَّة الهمايونية ومواكب الصُّرة، ترجمة: محمد حرب (القاهرة: مركز التاريخ العربي، 2023).


من المملوكي إلى العثماني:
الأثر الحضاري والادعاء الديني
يتشابه مدخل مدرسة السلطان حسن مع مدخل مدرسة أم السلطان شعبان، وهو تشابه ترك أثره الواضح على بعض مداخل العمائر العثمانية في تركيا، مقارنة بالتأثيرات السلجوقية. غير أن الدور الذي أضافه المعمار والفنان المملوكي على هذا العنصر ذي الأصل السلجوقي، سواء من حيث التطوير أو التناسق الجمالي، كان نتاج خبراته الطويلة في تشييد العمائر الحجرية، فضلاً عن الموروث الحضاري المصري العريق.
المداخل المعمارية وتأصيل "الأمانات المقدسة" بين الحقيقة والتوظيف السياسي

لقد ظهرت فنون معمارية متنوعة في إسطنبول، وجُلب لها المهرة والصنّاع من مصر وغيرها، وأُجبروا على الإقامة الجبرية لينقطعوا تمامًا لإنجاز نهضة عمرانية لعاصمة السلاطين. ومن هنا انتشرت طرازات أوروبية كالبَاروك والروكوكو خلال القرنين 11-12هـ/17-18م، واستمر تأثيرهما على العمارة الإسلامية حتى أواخر القرن 13هـ/19م.
وقد بدأ هذا التأثير يظهر بوضوح في العمارة العثمانية بعد دخول بلاد المجر في دائرة الإمبراطورية العثمانية سنة 1101هـ/1689م (معاهدة كارلوفيتش). وكان ذلك بداية تحرك تدريجي نحو أوروبا ولا سيما فرنسا. ففي عهد السلطان أحمد الثالث (1115-1143هـ/1703–1730م) بدأ يظهر تطور فني جديد، إذ أُرسل وفد رسمي سنة 1133هـ/1720م إلى باريس برئاسة رسول السلطان، وعاد بتقارير ورسومات وتخطيطات للقصور والحدائق الفرنسية. وقد أدخل هذا الوفد تأثيرات باروكية وروكوكوية انعكست في مرحلة “زهرة التوليب”، التي أثرت في المساجد والقصور والحدائق والبيوت والأسبلة العثمانية.
وكان أول جامع عثماني يتأثر بهذا الطراز هو جامع نور عثمانية في إسطنبول. بدأ بناؤه في عهد السلطان محمود الأول سنة 1161هـ/1748م، وانتهى في عهد السلطان عثمان الثالث سنة 1169هـ/1755م. يتألف مسقط الجامع من حرم وصحن: الحرم مربع تغطيه قبة ضخمة بقطر 25.75م، تحملها أربعة عقود كبيرة مدعّمة بأربعة أبراج ركنية، ويبرز المحراب بوضوح بشكل نصف دائري خارج جدار القبلة، ويحيط بالحرم رواقان جانبيان من طابقين بعقود باروكية متماوجة، أما الصحن فجاء بشكل نصف بيضي تقريبًا، متأثرًا بالفن الوافد الجديد، مع اختفاء الشادروان من مركزه، وللصحن أروقة مغطاة بقباب صغيرة تستند إلى أعمدة دائرية، تعلو زاويتي رواقه الجنوبي مئذنتان بشرفتين لكل منهما.
المسجد مكسو بالرخام، وتزين جدرانه زخارف باروكية واضحة، مثل العقود المتماوجة والأشكال المحارية وورق الأكانتس وتيجان الأعمدة المتميزة، مما أشار إلى ميلاد أسلوب باروكي جديد في العمارة العثمانية.
وفي سياق متصل، تواصل تركيا اليوم الاهتمام بما يُسمى “الأمانات المقدسة”، وهي مجموعة من المقتنيات التي نُقلت إلى إسطنبول عقب فتح السلطان سليم الأول لمصر عام 1517. وتُحفظ هذه المقتنيات منذ خمسة قرون في “الغرفة الخاصة” بقصر “طوب قابي” في إسطنبول، وتشمل: بردة النبي ﷺ وشعرة من لحيته الشريفة وآثار أقدامه، ومحفظة سِنّه الشريف الذي كُسر في غزوة أُحد، ورسائل وسيفه، ووعاء طعام يُنسب إلى النبي إبراهيم عليه السلام، وعصا النبي موسى عليه السلام، وسيف النبي داود عليه السلام، وعباءة النبي يوسف عليه السلام، ومفاتيح الكعبة المشرفة، ومحفظة الحجر الأسود، وسيوف خلفاء مسلمين، وبردة السيدة فاطمة رضي الله عنها.
ويؤكد مدير متحف “طوب قابي” مصطفى صبري كوتشوك أشجي أنّ هذه الغرفة خُصصت منذ عهد السلطان محمود الثاني لحفظ الأمانات، وكان حراسها نخبة مدربة من الجنود، يرافق وجودهم تلاوة متواصلة للقرآن بجوار “الخرقة الشريفة” منذ القرن السادس عشر حتى يومنا هذا.
ورغم هذا الاهتمام الشكلي، يلاحظ أن طريقة عرض القطع تستثمر العاطفة الدينية وتوظفها في خدمة محاولة التأكيد على شرعية الدولة العثمانية، التي سعت منذ سليم الأول إلى جمع كل ما يمكن ربطه بالنبي ﷺ ليكون في إسطنبول بدلاً من مكة أو المدينة. وهنا يبرز سؤال مشروع: هل جميع هذه الأمانات أصلية وصحيحة؟ وهل يصح مثلًا أن يُنسب وعاء طعام إلى النبي إبراهيم عليه السلام بعد آلاف السنين؟.
تُظهر المعطيات أن الحضارة العثمانية، التي يفاخر بها الأتراك اليوم، لم تكن نتاجًا أصيلًا خاصًا بهم بقدر ما كانت مزيجًا من حضارات متعددة: الرومانية والسلجوقية والفاطمية والمملوكية. فقد احتفظوا بآثار الروم واستثمروها، وتأثروا بالعمارة السلجوقية، ثم نقلوا صنّاع مصر المملوكية إلى إسطنبول لبناء قصورهم.
وكما قال إيلبير أورتايلي: “لقد نشأ جيل بأكمله في تركيا وهو يسمع قصة القصور العثمانية وإفلاس السلطنة… ومع زيارة الأتراك لعواصم أوروبا أدركوا أن إنفاق السلطنة في القرن التاسع عشر كان متواضعًا بحيث لا يُقارن بإنفاق الدول الكبرى الأخرى”.
إن الانبهار الأوروبي والانسلاخ عن الجذور جعل العثمانيين عالقين بين تقليد الآخرين دون تأسيس حضارتهم الخاصة. وكالغراب الذي يقلد مشية الحمامة، فلا هو احتفظ بمشية نفسه، ولا أتقن تقليد الحمامة.
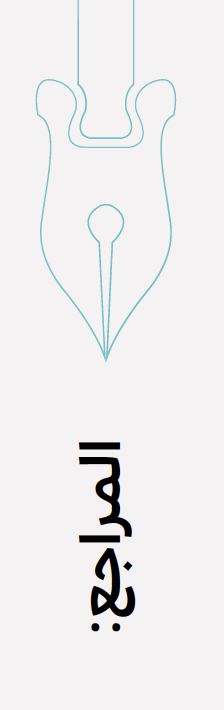
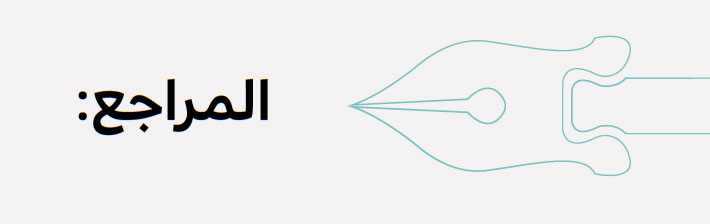
- أحمد آق وسعيد أوزتوك، الدولة العثمانية المجهولة (إسطنبول: وقف البحوث العلمية، 2014).
- ألبير أورتايلي، إعادة استكشاف العثمانيين، ترجمة: بسام شيحا (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2009).
- محمد صوان، يوميات السلطان: الحوادث الهامة في تاريخ الدولة العثمانية ودلالاتها (الجزائر: دار الروافد، 2020).