
السلطان المُعتلّ:
محمد الثالث بين سفك الدماء وفوضى الحكم
منذ بدايات الدولة العثمانية، وخصوصًا مع اتساع رقعتها الجغرافية وتنوع شعوبها، برزت مشكلة جوهرية تهدد العرش: صراعات الوراثة بين أبناء السلطان. كان الحل التقليدي في دول المشرق الإسلامي يتمثل في تقسيم الملك أو تغليب الأقوى عسكريًا، مما يؤدي إلى حروب طاحنة. أما العثمانيون فابتكروا ما اعتبروه حلاً وقائيًا؛ وهو قتل الإخوة الذكور للسلطان الجديد فور اعتلائه العرش. تحوّل هذا السلوك الوحشي إلى ما يشبه القانون العرفي غير المكتوب، ثم جرى تقنينه في عهد محمد الفاتح تحت مبدأ درء الفتنة عن الدولة. وهكذا صارت السلطنة تُفتتح عادة بمجزرة أسرية، يتكرر مشهدها جيلاً بعد جيل.
قتل إخوته وابنه.. وحوَّل قصر السلطنة إلى كهف من الكآبة والدموية.

محمد الثالث: نموذج متطرف للقانون الدموي
في هذا السياق نسلط الضوء على حكم محمد الثالث (1595–1603)، الذي اعتلى العرش في سن الثامنة والعشرين، ولم يكن يملك من الخبرة أو الكفاءة ما يضمن له السيطرة على الدولة، فاعتمد على أسهل وسيلة رسّخها أسلافه: القتل الجماعي لإخوته. حيث أعدم السلطان الجديد تسعة عشر أخًا في يوم واحد. مشهد كابوسي لا مثيل له في تاريخ البلاطات الإسلامية، إذ لم يكونوا مجرد أسماء على الورق، بل أطفال ومراهقون يعيشون معه في القصر، يمرحون تحت سقف واحد، ثم سيقوا جميعًا إلى المقابر بقرار سلطاني بارد. هذا السلوك الدموي لم يكن شذوذًا فرديًا، بل تجسيدًا متطرفًا لقاعدة عثمانية صارت شرطًا للبقاء في الحكم. وإذا كان أبوه مراد الثالث قد افتتح حكمه بقتل خمسة من إخوته، فإن محمد الثالث بالغ في تطبيق القاعدة حتى بلغت ذروتها.
لم يتوقف محمد الثالث عند حد الإخوة. بل اختتم عهده بجريمة أبشع من حيث الرمز: قتل ابنه وولي عهده الأمير محمود. تعلّلت الجريمة بشائعة عن انقلاب يعدّه الفتى الذي لم يتجاوز السادسة عشرة. صدّق السلطان الشائعة، وزاد الطين بلة أن السلطانة صفية –والدة السلطان– كانت طرفًا في المؤامرة، لما بينهما من صراع مع والدة الأمير محمود، ورغبتها في إقصائه عن وراثة العرش. فأمر السلطان بقتله، ثم دخل غرفته ليتأكد من خروج روحه. هكذا دارت دورة الدم كاملة: بدأ محمد الثالث حكمه بقتل إخوته، وختمه بقتل ابنه.
مقارنات تاريخية: بين محمد الثالث وأسلافه
- محمد الفاتح (1451-1481): أول من رسّخ “قانون قتل الإخوة” بصياغة شبه رسمية، إذ نصّ في “قانون نامة” على جواز قتل الإخوة درءًا للفتنة. وبذلك أعطى الغطاء الشرعي لما صار لاحقًا عرفًا ثابتًا.
- سليم الأول (1512-1520): قتل إخوته وأبناءهم فور اعتلائه العرش، لكنه برز بإنجازاته العسكرية التي غطّت على دموية بدايات حكمه.
- مراد الثالث (1574-1595): والد محمد الثالث، افتتح عهده بقتل خمسة من إخوته. لكنه ترك لابنه إرثًا ثقيلًا من الفساد الإداري والاعتماد على الجواري.
- محمد الثالث (1595-1603): تفوق على الجميع في وحشيته: قتل تسعة عشر أخًا وابنه، ولم يُعرف عنه إنجاز يبرر هذا العنف، بل اقترن اسمه بالفوضى والضعف.
من هذه المقارنة يظهر أن قتل الإخوة كان “ضرورة سياسية” في نظر العثمانيين، لكنه مع محمد الثالث تحوّل إلى عبث دموي بلا مقابل. فإذا كان بعض أسلافه قد عُرفوا بالفتوحات أو الإصلاحات، فإن محمد الثالث لم يترك إلا سجلًا أسودًا يُعرف به تاريخه.
البعد الاجتماعي والنفسي لظاهرة قتل الإخوة
هذا التقليد لم يكن مجرد إجراء سياسي، بل خلّف آثارًا عميقة، تمثلت بثقافة الخوف في القصر، حيث نشأ الأمراء العثمانيون في أجواء من الرعب والترقب، يعلمون أن مصيرهم عند موت والدهم قد يكون الموت. وهذا أنتج أجيالًا من السلاطين المعزولين، يفتقدون الاستقرار النفسي. كما ساهم في إضعاف الرابطة الأسرية، فبدلاً من أن تكون الأسرة الحاكمة وحدةً متماسكة، صارت بؤرة صراع ومجازر. إضافةً إلى انعكاس الأمر على الرعية، إذا كان السلطان لا يتورع عن قتل إخوته وأبنائه، فكيف يُنتظر منه رحمة بالرعية؟ وهكذا صار العنف جزءًا من صورة الدولة.
فوضى الإدارة وحكم الجواري
لم تكن دموية محمد الثالث سوى وجه واحد لأزمته. الوجه الآخر هو الفوضى الإدارية. ففي عهده انهارت قيمة العملة، وبيعت المناصب، وتكررت الهزائم العسكرية، واندلعت الثورات حتى وصلت إلى إسطنبول. وعجزت الدولة عن دفع رواتب الجنود، فانقلبوا إلى النهب والفوضى. وفي ظل انشغال السلطان بملذاته، برزت السلطانة صفية كحاكم فعلي. أغرقت ابنها بالجواري لتصرفه عن شؤون الدولة، بينما أدارت هي الجهاز الإداري والسياسي. وتحوّل القصر إلى ساحة نفوذ نسائي متشابك، يُعرف في التاريخ العثماني بمرحلة سلطنة الحريم.
خلاصة: منطق الحكم المريض
تجربة محمد الثالث تكشف عن جوهر الأزمة في السلطنة العثمانية، المتمثلة بقانون قتل الإخوة الذي بدأ كحل لتفادي الفتنة، وانتهى ليصبح أداة للدموية والعبث. والفساد الإداري الذي أفرغ الدولة من قوتها، وحوّل الجيش إلى عصابة مرتزقة، كما أن تحكم الجواري في القصر حوّل مركز القرار إلى شبكة من المؤامرات الشخصية. فهكذا اجتمعت في شخص محمد الثالث كل معالم الانحدار العثماني: منطق العرش يبدأ بقتل الإخوة، وينتهي بفوضى تُدار من وراء ستائر الحريم.
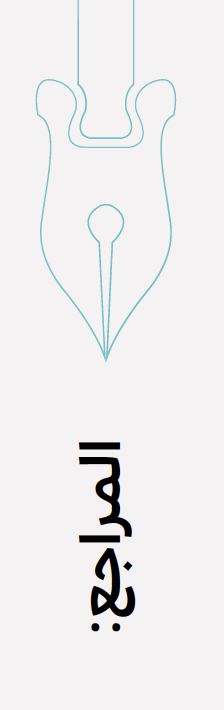
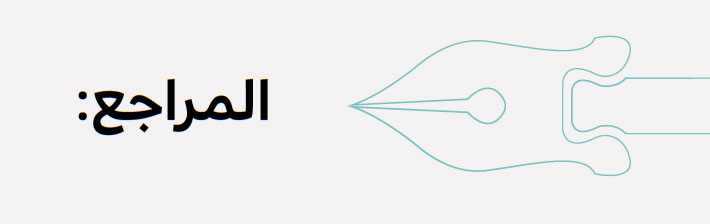
- أحمد آق وسعيد أوزتوك، الدولة العثمانية المجهولة (إسطنبول: وقف البحوث العلمية، 2014).
- ألبير أورتايلي، إعادة استكشاف العثمانيين، ترجمة: بسام شيحا (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2009).
- عبدالعزيز الشناوي، الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها (القاهرة: مكتبة الأنجلو، 1980).
- محمد صوان، يوميات السلطان: الحوادث الهامة في تاريخ الدولة العثمانية ودلالاتها (الجزائر: دار الروافد، 2020).
- محمد فريد بك، تاريخ الدَّولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي (بيروت: دار النفائس، 1983).
