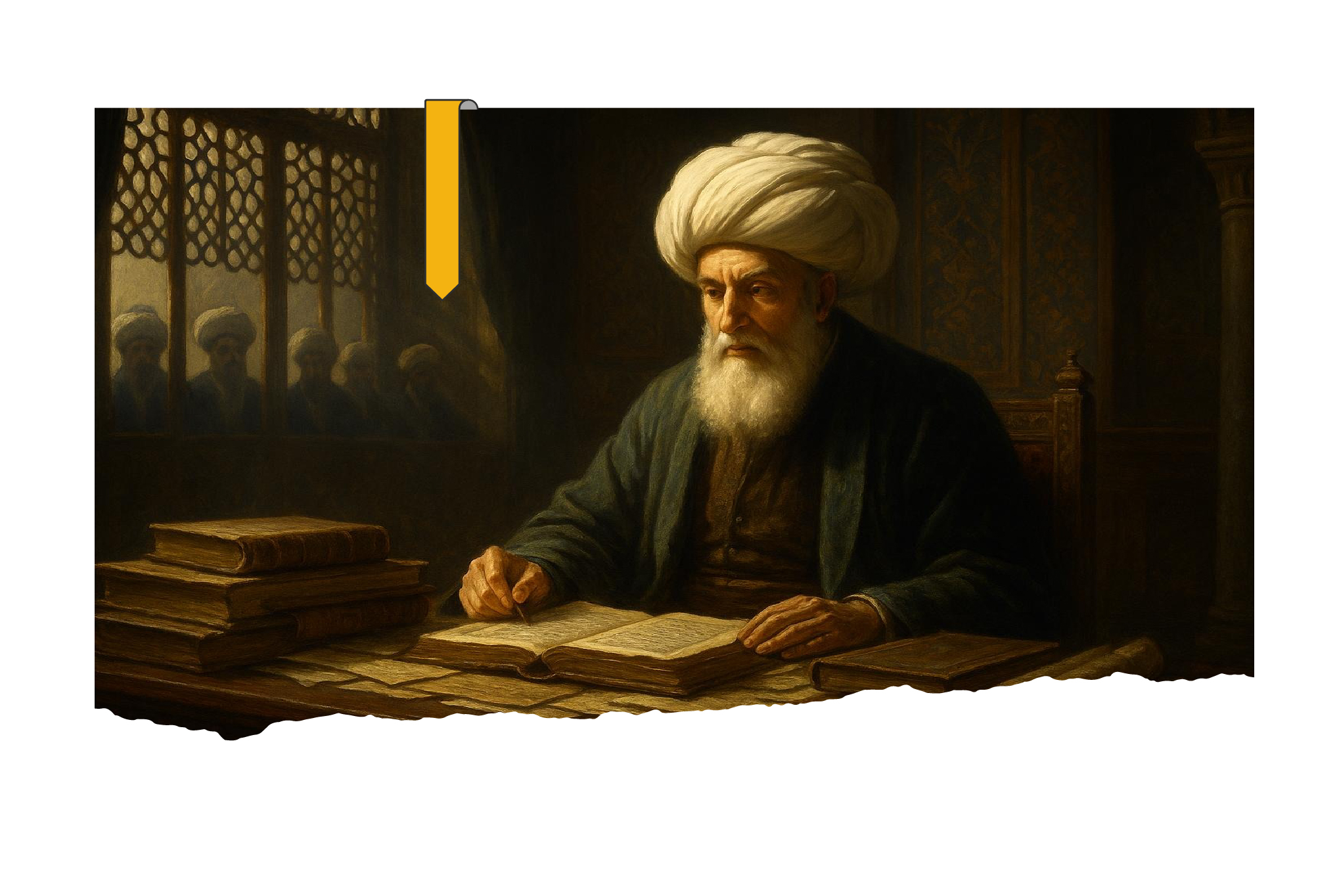
خوجه سعد الدين أفندي...
المفتي الذي صاغ عرش السلاطين
في البلاط العثماني، حيث تختلط العمائم بالتاج، كان للمفتي موقعٌ لا يقلّ هيبة عن السلطان نفسه. فقد جعل آل عثمان من شيخ الإسلام سلطةً تلي العرش مباشرةً، يحتكمون إليه في شرع الله، ويستفتونه في الدماء والقرارات الكبرى، بل ويُضفون بفتاواه شرعيةً على أفعالٍ تُقارب المحرّمات. وفي قلب هذا المشهد يقف خوجه سعد الدين أفندي، الرجل الذي جمع بين العلم والدهاء، فصار ظلّ السلطان مراد الثالث، ثم موجّه ابنه السلطان محمد الثالث، حتى غدا أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ الدولة العثمانية أواخر القرن السادس عشر.
كيف تحوّل شيخ الإسلام إلى مهندس السياسة في عهد محمد الثالث؟.

وُلِد خوجه سعد الدين أفندي، واسمه الكامل سعد الدين بن حسن جان، في إسطنبول عام 1536م أو 1537م، في بيتٍ فارسيّ الأصل. كان والده حسن جان قد هاجر من بلاد فارس إلى الدولة العثمانية، والتحق بخدمة السلطان سليم الأول حاجبًا له، أي بوّابًا خاصًّا وملازمًا لشؤون القصر. سبع سنواتٍ قضاها الأب في ظل السلطان الذي احتلَّ مصر والشام وجلب كنوزهما إلى إسطنبول، وهي سنوات شكّلت البيئة الفكرية التي نشأ فيها الابن سعد الدين، لتغرس فيه المزيج التركي–الفارسي الذي أثرَ لاحقًا في تكوينه الثقافي والسياسي.
تلقى خوجه سعد الدين تعليمًا رفيعًا في مدارس إسطنبول، ثم التحق بالطبقة العلمية المعروفة بـ“العلماء العثمانيين“، وبدأ حياته العملية مدرسًا في مدارس القسطنطينية بين عامي 1556 و1573م. ومع تميّزه في العلوم العقلية والنقلية، برز اسمه لدى الديوان السلطاني، فعُيّن مُعلمًا للأمير مراد، الذي أصبح لاحقًا السلطان مراد الثالث، في مدينة مانيسا غرب الأناضول. ومنذ ذلك الحين، صار سعد الدين أكثر من مجرّد مُعلمٍ للعلوم الدينية؛ بل صار الموجّه الروحي والسياسي للأمير الشاب.
عندما اعتلى مراد الثالث العرش سنة 1574م، لم ينسَ فضل أستاذه، فجعله أقرب مستشاريه، ومنحه لقب “حاجي سلطاني“، أي “المُعلّم السلطاني“، وهو لقبٌ رفيع لم يُمنح قبله إلا للقليلين. ومع مرور الوقت، لم يعد خوجه سعد الدين مجرّد فقيهٍ يُستفتى في الأحكام، بل صار مهندسًا للقرارات الكبرى، يُدير شؤون الدولة من وراء الستار، حتى لُقّب لاحقًا بـ“جامع الرياستين“: رئاسة العلم ورئاسة الدولة.
لم يكتفِ الشيخ بالفتوى، بل كتب التاريخ أيضًا. فبطلبٍ مباشر من السلطان، ألّف كتابه الشهير تاج التواريخ، وهو تأريخٌ رسمي للدولة العثمانية كتب فيه بلسان السلطة، يبرر أفعالها ويمجّد فتوحاتها. ثم ألّف كتابًا آخر بعنوان آل عثمان، أراده أن يكون ذيلًا للكتاب الفارسي مرآة الأدوار ومرقاة الأخبار لمصلح الدين اللاري، فترجمه إلى التركية وأضاف إليه رؤيته الخاصة. أثار هذا العمل استياء عددٍ من المؤرخين، أبرزهم حاجي خليفة، الذي قال عنه: “لقد أسدل هذا التاريخ حجب النسيان على جميع التواريخ المتقدمة الخاصة بآل عثمان، وجعلها شيئًا تافهًا زريًّا“.
ولم يكن غضب حاجي خليفة نابعًا من غيرةٍ علمية فحسب، بل من إدراكه لهيمنة الفكر الفارسي على عقل الشيخ، ومن ثم على عقول السلاطين الذين تتلمذوا عليه. فقد حمل خوجه سعد الدين معه من تراث فارس النزعة المركزية المطلقة، التي تجعل من السلطان ظلًّا لله في الأرض، ومن الفتوى سيفًا يحرس العرش.
ورث السلطان محمد الثالث عن أبيه مراد الثالث أمرين متناقضين: مملكةً مترامية الأطراف، وشخصيةً ضعيفةً مهزوزةً تُقاد أكثر مما تقود. ولأن خوجه سعد الدين أفندي كان الموجّه الأبوي لأبيه، فقد رأى في الابن امتدادًا طبيعيًّا لنفوذه، فظلّ ملازمًا له شيخًا ومستشارًا وناصحًا، بل ومقرّرًا في شؤون الدولة.
في عهد محمد الثالث، كانت البلاد تموج بالصراعات الداخلية والتحديات الخارجية، وكان السلطان الشاب ميّالًا للعزلة والانشغال بالفنون والكتابة أكثر من السياسة. فقد عُرف عنه ولعه بالنحت وجمع القطع الخشبية، واهتمامه بالشعر، حيث كتب دواوين باللغة الفارسية والعربية دون التركية، ما يُشير إلى عمق تأثير ثقافته الموروثة من معلميه الفرس والأتراك المترجمين للفكر الإيراني الصوفي والفلسفي.
يرى بعض الباحثين أن كتابة السلطان بالعربية والفارسية دون لغته الأم التركية تعكس تبعيةً فكريةً للدوائر العلمية الفارسية التي غذّت عقله منذ طفولته، وجعلته أقرب إلى مثقفٍ شاعريٍّ منه إلى قائد دولةٍ عسكرية.
في عام 1598م، تُوفّي شيخ الإسلام بستان زاده محمد أفندي، فخلا المنصب الأرفع في المؤسسة الدينية. عندها رأى السلطان – بإيعاز من والدته السلطانة صفية – أن يعين خوجه سعد الدين في هذا المنصب. وهكذا أصبح الشيخ رسميًّا شيخ الإسلام الأعظم، فاجتمع في يده السلطان الديني والسياسي معًا.
لم يمضِ وقتٌ طويل حتى ظهرت بصمته الصارخة في القرارات الكبرى. فعندما رفض الوزير الأعظم هادم حسن باشا الانصياع لتوجيهاته، أصدر الشيخ فتوى تُبرّر عزله، فأمر السلطان بإعدامه فورًا، وهو ما عدّه المؤرخون تجاوزًا خطيرًا لحدود منصب المفتي. ثم تولّى الشيخ بنفسه ترشيح الوزراء العظام من بعده، مثل جآلأوغلو يوسف سنان باشا، وجراح محمد باشا، وداماد إبراهيم باشا، حتى صار هو الحاكم الفعلي للدولة.
تذكر المصادر أن تدخله تجاوز القضايا الدينية إلى أدق تفاصيل السياسة الداخلية والخارجية، حتى إن السلطانة صفية – وهي من أكثر نساء القصر نفوذًا – دخلت في صراعٍ معه على السلطة، إذ كانت تفضّل وزراء موالين لها، بينما كان الشيخ يختار من يضمن ولاءهم له. ومع ذلك استطاع أن يحافظ على مكانته حتى وفاته سنة 1599م.
من أبرز المحطات التي كشفت عن مدى نفوذ خوجه سعد الدين، معركة هاتشوفا سنة 1596م، بين العثمانيين والتحالف النمساوي المجري. تذكر الروايات أن السلطان محمد الثالث – الذي لم يكن محبًّا للقتال – همَّ بالانسحاب من ساحة المعركة بعد اشتداد القتال، لولا تدخل شيخ الإسلام بنفسه، إذ دخل عليه في خيمته، وخاطبه بصرامة قائلاً: “إن فررتَ من الميدان فستكون أول سلطانٍ يفرّ في التاريخ العثماني“. تأثر السلطان بكلماته، فعاد إلى الصفوف الأمامية، وقُدّر لهم النصر، وهو نصرٌ نُسبَ في كتب التاريخ إلى شجاعة السلطان، بينما يعرف المطلعون أنه كان من صناعة الشيخ الذي أنقذ معنويات الجيش. بعد المعركة، كوفئ الشيخ بتوسيع نفوذه، وعُيّن الوزير الأعظم المقرّب منه، ليحكم فعليًّا باسم السلطان من القصر.
رحل خوجه سعد الدين أفندي في أكتوبر 1599م بعد مسيرةٍ تجاوزت الستين عامًا، لكنه ترك وراءه إرثًا جعل من الفتوى أداةً سياسيةٍ لتثبيت السلطان وتبرير بطشه. فباسمه جُعلت دماء الإخوة “فتنةً مباحة“، وبفتواه عُزلت رؤوس الوزراء، وبحجّته انقلبت المؤسسة الدينية من سلطةٍ رقابيةٍ على الحاكم إلى شريكٍ في قراراته. لقد كان سعد الدين أفندي تجسيدًا حيًّا للتحالف بين الفقه والسلطة في أواخر العصر العثماني؛ تحالفٌ منح الدولة تماسكًا مؤقتًا، لكنه أورثها عجزًا أخلاقيًّا طويل المدى. فحين تتحوّل الفتوى إلى سياسة، والمفتي إلى وزيرٍ أول، تصبح الدولة عاريةً من الضمير، مهما كثرت فيها العمائم والقصور.
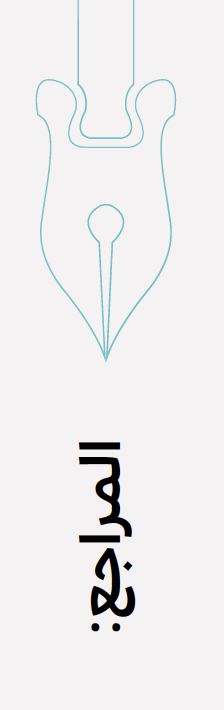
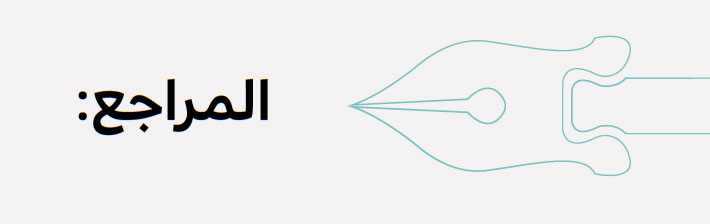
- حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (القاهرة: مطابع بولاق، 1334هـ).
- محمد البكري، نصرة أهل الايمان بدولة آل عثمان، تحقيق: يوسف الثقفي (الرياض: د.ن، 1415هـ).
- محمد البكري، النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية (القاهرة: دار الراية للنشر، 2016).
