
لجأ لكتابتها دعمًا لدعايته وصلاحه المزعوم
مذكراته تعكس شخصيته المضطربة
جاءت مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني في خمسة أقسام:
– السياسة الداخلية.
– السياسة الخارجية.
– الشخصية الإسلامية.
– سياسة الإصلاحات.
– الشخصية.
يتناول القسم الأول من المذكرات عناوين مختلفة تنوعت بين الكتابة عن الشبان الأتراك والدستور (1892م)، حيث كتب عبارات غريبة مثل: “إن مبلغ الطيش الذي بلغه الأتراك الشباب في عهد أخي المريض، وإن الإمبراطورية العثمانية انحطت أخلاقيًّا وماليًّا” تلميحات عجيبة منه وتعليق أسباب التدهور المجتمعي والاقتصادي على شخص اعتبر الجميع بأنه مريض وغير مسؤول، وللعلم فإن مدة حكم مراد الخامس في مجملها ثلاثة أشهر. ويذكر أن عمه عبد العزيز خُلع عن العرش ثم انتحر في خبر يسوده الغموض -على حد وصفه- ويذكر عن أخيه بـ “ثم جُنَّ أخي مراد وسُجن”.
ونجده يسهب في ذكر الأرمن وأنهم هم المسؤولين عن الفوضى في بلاده، ولابد من الإعلاء للعنصر التركي في الأناضول، وفي حديثه عن إعلان الدستور يقول: “يجب أن أفتتح مجلس المبعوثان وأعلن الدستور لكي أظهر أنني أقوم بأمر هام”. ويتضح ضعف الشخصية رغم الكتابات التي تغص بها المصادر وتكررها المراجع. وقد أطلقت عليه عدة ألقاب منها: خليفة رسول الله، وأمير المؤمنين، وقيصر الروم، وسيد الأوغوز المستبد، والسلطان الأحمر، وصاحب الشوكة.
وكتب رسالة لشيخ الطريقة الشاذلية: “أرفع عريضتي هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية، إلى مفيض الروح والحياة، إلى شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندي أبي الشامات، وأقبّل يديه المباركتين راجيًا دعواته الصالحة. إنني بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلاً ونهارًا، وما زلت محتاجًا لدعواتكم القلبية” وقد تم تهريب هذه الرسالة لشيخه وهو في منفاه.
وتحت عنوان “خط حديد بغداد (1898م)” كتب ما يلي: “يجب علينا أن نعمل رغم أنف إنجلترا الذين يبذلون ما في وسعهم للحيلولة دون تنفيذ مشاريعنا، فبفضل خط حديد بغداد سيعود طريق أوروبا–الهند إلى سابق نشاطه، فإذا أوصلنا هذا الخط بسوريا وبيروت والإسكندرية وحيفا نكون قد أوجدنا طريقًا تجاريًّا جديدًا. ولن يقتصر هذا الطريق على در الفوائد الاقتصادية العظيمة لإمبراطوريتنا، بل ستتعداها إلى الناحية العسكرية فيدعم قوة جيشنا هناك”. وأين باقي العالم الذي سيطرت دولته عليه؟ وأين شعاره “يا مسلمي العالم اتحدوا؟” لكن الأمر خاص بالعثمانيين وقوميتهم التركية وجيشهم.
لقد كان الطموح مصيدة أحلام عبدالحميد الذي يراها في مخيلته، لأنه كتب عن نفسه أنه كثير التخيل، وذلك مدعاة في أن تعتلي الشخصية بصاحبها وتبعده عن أرض الواقع.
ومن الأمثلة التاريخية والأحداث المهمة التي لابد أن نسلط الضوء عليها خياله الذي اتسع بإنشاء سكة حديد تربط أرجاء سلطنتهم بكل الشعوب من حولهم، وكان حال الواقع يقول إن الدولة لا تستطيع أن تقف أمام ميزانية عملاقة لتحقيق ذلك، ولكن الأحداث تسارعت بتقديم الإغراءات وتسهيل تلك المهمة بأن رؤوس الأموال لها منابع متعددة ومنها أموال العرب التي تم جمعها ضرائبَ وإتاوات بغير وجه حق، واستصراخ العالم الإسلامي بأن يتقدموا بالبذل من أجل إنشاء شبكة حديدية تحقق تيسير وسهولة القدوم لأداء مناسك الحج والعمرة.
استهدف الحرمين ودمر قناة السويس لمصلحة اقتصاد إسطنبول.

ونتساءل ما تلك الإغراءات التي قُدمت لخيال السلطان عبدالحميد وجعلته يسَطِّر في صفحات التاريخ بأنه المنجز لذلك المشروع العملاق في حينه؟ إن ذلك المشروع سيسهم في تقليل انتهاج الدول الأوروبية من سياسة التكتل ضد بلاده. ولقد اعتمد السلطان مباشرة العمل في المشروع رغم أنه لم تكتمل الاعتمادات المالية أو خبرات الفنيين أو حتى مصادر تمويل وغيرها الكثير من المغريات، لكن الخيال الواسع كان المتغلب. وقال: “سيتم مد هذا الخط وسنستغني عن قناة السويس، وستربط إسطنبول بالمدينتين المقدستين مكة والمدينة، وسنتمكن من تأمين المواصلات المدنية والعسكرية بكل أمان واطمئنان”. في تدمير واضح لاقتصاد المصريين ولمصلحة إسطنبول.
ويتناول القسم الثاني السياسة الخارجية، حيث حمل عنوانًا مهمًّا جدًّا يفتح أبوابًا للتساؤلات وهو “الحملات الصليبية على الدولة العثمانية” حيث ذكر: “الحملات الصليبية لم تتوقف قط ولا يزال غلادستون العجوز يسير على خطى البابا في هذا السبيل -ويتساءل- وهل تستحق الدولة هذه الحملات وقد آوت النصارى الهاربين من جحيم الصراخ المذهبي في الغرب خلال القرون الوسطى. ألم تكن الدولة العثمانية هي الملجأ الوحيد لليهود الناجين من بطش محاكم التفتيش في إسبانيا”. ولم يأتِ على ذكر الحوادث الكارثية التي حلت بالمسلمين في نفس الجهات التي استقبلت دولته منها اليهود والنصارى.
اعترف بأن الدولة العثمانية الملجأ الوحيد لليهود الناجين من إسبانيا.

وفي القسم الثالث اختار أن يكون الحديث عن الشخصية الإسلامية، وقد تناول فيه عناوين متضاربة مثل: الإسلام دين الحضارة والتسامح -وقصد بذلك التسامح الزواج من غير المسلمات- وكأنه هنا يصدر فتوى لتحليل ذلك رغم أن الإسلام لم يحرمه، وهنا سلوك عجيب من شخصيته وفكره الديني حيث يقول: “النصيب كلمة طالما أضرت بالناس، وأوقعتهم في مصائب، ولا مكان في القرآن لفكرة النصيب، بل لقيت رواجًا في القرون الأخيرة على ألسنة الناس بسبب كسلهم وقلة فهمهم. وأصبحت إن شاء الله ملجأ لكل من يريد ستر ضعفه وخموله”. ثم يقحم موضوع التوكل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالاتكال على الله. وهو أمر غريب في عدم معرفته بنصوص القرآن، ولا غرابة فالطريقة الشاذلية طغت على فكره (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) [المائدة: 11]. وغيرها من الآيات المعززة بأحاديث المصطفى عليه السلام (أولئك لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) [البقرة: 202]. (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) [النساء: 322].
كما أتى على ذكر التعصب رغم أنه وأسلافه من أشد المتعصبين لعرقهم وإعلائه، فهو يرفض أن تصفه أوروبا بالمتعصب.
وكتب عن الخلافة والشيعة فقال: “وإنه لمن دواعي الأسف ألا يقوم أي تعاون بيننا وبين إيران، وقد كان عليها أن تسعى إلى التقارب معنا كي لا تصبح ألعوبة بيد روسيا وإنجلترا”. وما أسباب ذلك العداء وهدر الحقب السابقة دون تقارب، لأن المرحلة كانت مرحلة حرب المصالح، وتضررت الدولة بسياسة سلاطينها وعجرفتهم.
وخصص القسم الرابع عن التعليم عند العثمانيين والتطور الفني وآدابه. والسؤال يتكرر أين الحديث عن جهات الدولة الأخرى؟ ولكن الإهمال الشديد هو ما يثبته من خلال مذكراته تجاه الدول العربية خاصة والإسلامية عامة. وذكر الامتيازات بعنوان “حقوق الأمم” حيث ينتقد الصحافة ويتذمر منها، ويشكك في مصداقية أخبارها، وعلة ذلك أنها كانت تكشف ألاعيب دولته، ولقد لقيت الصحافة والصحفيون تعتيمًا وتكذيبًا شرسًا منه. وما أشبه الليلة بالبارحة “أردوغان والصحافة”.
أما القسم الخامس والأخير عن شخصيته، رغم أنه شرحها من خلال أسلوب كتابته للأقسام السابقة، فخصص عنوانًا عن “الشخصية” وأنه يعاني من الانتقاد لانزوائه، ويحقد على من ينتقده لأنهم يعلمون كيف نشأ والظروف السيئة من قسوة إخوته عليه، والأمر العجيب أنه يراقبهم أثناء اللعب والمرح ولا يشاركهم رغم أنه كتب عن معاملة أخيه مراد له ويصف أخاه بالمسكين، ويظهر الاضطراب في كل مرة يذكر فيها أخاه مراد ونهايته، ويلوم كل من لم يستطع فهمه. والشك يحاصره في أن مجرد اعتلائه العرش وجد نفسه محاطًا بأناس يريدون تقييده بشباك المؤامرات والدسائس. وذلك ديدن أسلاف البيت العثماني، وحريم السلطان -الحرملك-. ذلك الشك ينم عن إخفائه حقائق تخص مقتل عمه عبد العزيز، وجنون أخيه مراد. ثم يختم بالحديث عن أركان القصر وذكر رجال الدولة وتنوعهم وشكّه مرارًا وتكرارًا في الجميع.
وينتقل إلى الحديث عن الموسيقى، والقطع الموسيقية المهداة له وهي من أمم وقوميات مختلفة، وأنه لم يستطع أن يعطيهم الأعطيات كأسلافه، واكتفى بالأوسمة وكتب الثناء، وذلك تأكيد على الخزانة الفارغة. رغم أنه يتحدث في عنوان “عبد الحميد الشحيح” أنه جمع ثروة طائلة أخفاها خارج البلاد -يقصد ألمانيا-، لأن المصارف في إسطنبول غير مأمونة. ويوثق بقوله: “ولا داعي للاستغراب فكل حاكم يعمل ما عملته”. وآخر العناوين كانت عن الجاسوسية، والمطبوعات الفرنسية التي كلفته غاليًا فيقول: “فالصحفي اليوناني نيكولايدس الذي يعيش في باريس يقبض منا كل عام مبالغ طائلة كي يصدر جريدته “نوتر أورغان” لقد كان علينا أن نفهم في أوانه ضرورة عدم الاكتراث بالقيل والقال، وكان حريًّا بالأوسمة التي وزعناها وكأنها أدوات زينة أن توزع على بعض الصحفيين كي يقفوا إلى جانبنا، فإنهم إذا حازوا على هذه الأوسمة كانوا صوتنا المسموع في كل مكان. ولكن فات الأوان وأصبحت آلاف الصحف في الصف المعادي”. وهنا يتحسر على سلوكيات دولته وفترة حكمه في أنه دعم الصحف الخارجية حتى تكون معه ولكنها انقلبت ضده رغم التمويل السخي، وذلك سبب من أسباب خلو الخزينة في الدولة وإفلاسها.
تلك بعض من تصرفات السلطان عبدالحميد الثاني وسلوكياته وتبقى مذكراته تحوي الكثير من التحليلات والوصول من بين السطور إلى حقائق كان يعتقد بأنها غامضة.

مذكرات عبدالحميد الثاني تفضحه
السلطان "المرتشي" يعشق الجاسوسية ويشرعنها
البقشيش الحلال
برز بجلاء اضطراب الفكر والمعايير المغلوطة لبعض المفاهيم والقيم، التي كان يتبناها السلطان عبدالحميد الثاني، والتي تخالف الشريعة الإسلامية لما فيها من تأثيرات وخيمة على المجتمع، ألا وهي مسألة “البقشيش” أو الهدايا التي كان يتلقاها الموظفون الحكوميون من الناس إزاء خدمتهم وأداء واجبهم الوظيفي نحوهم، وكلنا ندرك خطورة ذلك الأمر على النفس البشرية وعلى المجتمع والأداء الحكومي، فقد شدد الإسلام في التحذير من مثل ذلك الخلق، وفي الحديث عن النبي صَلى الله عليه وسلم أنه قال: “مَنِ استعمَلْناه على عمَلٍ فرَزقْناهُ رزقًا، فما أخذَه بعد ذلك فهو غُلولٌ”. ولقد أجمعت الأمة بعلمائها على أن هدايا العمال سُحت، لأنه إنما يُهدَى إلى العامل ليغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه، ويبخس بحق المساكين، ويُهدى إلى القاضي ليَميل إليه في الحُكم، أو لا يُؤمَن من أن تحمله الهدية عليه. وأين السلطان من تلك الأحاديث النبوية الشريفة ومن إجماع الأمة؟ وللأسف وجدناه يحاول تسويغ تلك الغلول (الهدايا) وانتشارها بين موظفي الحكومة العثمانية بأسباب واهية ومقارنتها بما كانت تفعله بعض الحكومات الأوروبية في السابق، والتي عدّها من العادات.
وهنا تظهر لنا وجهة نظر السلطان عبدالحميد بأن الموظف لا يمكنه أن يعيش على الراتب الذي يحصل عليه من الدولة، لذا يرى أن المبلغ الذي يحصل عليه الموظف من الهدايا من حقه الطبيعي، بل عدَّه الناس أمرًا طَبَعِيًّا، مما جعل من الهدية عرفًا ومؤسسة وطنية. ثم أكد ذلك المُسَوِّغ بأن الدولة فقيرة ومستمد ذلك من فقر الناس، فالدولة لا يمكنها أن تدفع الرواتب بصفة شهرية منتظمة، بل اعتبر ذلك الأمر إنساني بحت يجب تفهمه، فالعيال في البيت جائعون ينتظرون النجدة من الهدايا، وإن أي موظف في أي أمة وضعها كوضع العثمانيين لابد أن يتصرف كما يتصرف موظفونا هنا.
ويقول في مذكراته ما نصه: “والحقيقة أن أصول الرشوة سيئة للغاية. إنها عملية تضر مجتمعنا كثيراً. يمكن أن نصفح عن الهدية “البقشيش” المقدمة إلى صغار الموظفين ممن قلّت رواتبهم وكثر عيالهم، ولكن كبار الموظفين يقبضون أساسًا رواتب ضخمة، فعليهم أن يحيلوا هذه الهدايا إلى خزينة الدولة لا أن يأخذوها” كما أنكر على والي بيروت ومدير الشرطة وقائد المنطقة الساحلية بوصفه لهم بأنهم خونة؛ لأنهم أخذوا ثلاث ليرات تركية كرشوة من ملايين المهاجرين غير الشرعيين ومنحوهم الوثائق الرسمية، وبذا غصبوا ملايين الليرات من خزينة الدولة.
حقيقة يقف الإنسان مصدومًا أمام شرعنة الرشوة بمسمى “البقشيش” في الدولة العثمانية وبرعاية رسمية وسلطانية فاخرة، فالسلطان عبدالحميد الثاني أسهم وأسس للفساد الإداري والحكومي في الدولة وعمّقه في عموم ولاياتها طيلة سنوات حكمه المظلمة وضربت الرشوة بأطنابها في خلالها، والسبب هو تبريراته الواهية غير المقبولة شرعًا ولا عقلاً، وشرّعها للموظف الصغير وأنكرها على الموظف الكبير ليس لحرمتها ومخالفتها للشريعة الإسلامية، بل لأن تلك الهدايا هي ملك لخزينة الدولة، فيا للعجب ممن يدعي أنه خليفة المسلمين الذي لم يقع ظلّه على الأرض بل وقع على الهدايا والرشاوى.
السلطان المهووس بالجاسوسية
شكلت الاستخبارات في عهد السلطان عبدالحميد الثاني أحد أهم الركائز الأمنية التي استطاع السلطان أن يدير بها شؤون الدولة الداخلية والخارجية واللعب على حبالها في تعاملاته مع الجميع دون استثناء، حتى قيل: “إن تحت كل حجر في الدولة مخبر عثماني” وبهذه العقلية الاستخباراتية والجاسوسية استطاع السلطان البقاء في سدة الحكم ثلاثة عقود، فأراد بذلك بناء جدار ضخم من التجسس والمخابرات على شعبه وضرب بعضهم ببعض حتى تصل إليه النتيجة والمحصلة التي كان يريدها بخبث ودهاء، وبنى بذلك دولة قامت أركانها على الخوف من الكل وعدم الثقة بالكل، وساق -كالمعتاد- الأسباب لفعل ذلك الأمر هو الحفاظ على وحدة الإمبراطورية من الاختراق الخارجي، رغم إدراكه جيدًا أن الدولة مخترقة منذ أيام السلطان القانوني الذي فتح الباب للدول الأوروبية منذ قرون مضت بمنحه فرنسا امتيازات جعلها تتدخل بطرق مختلفة.
قيل في عهده "إن تحت قيل في عهده "إن تحت عثماني".

بنى دولة قامت أركانها على خوف الكل وعدم الثقة بالكل.

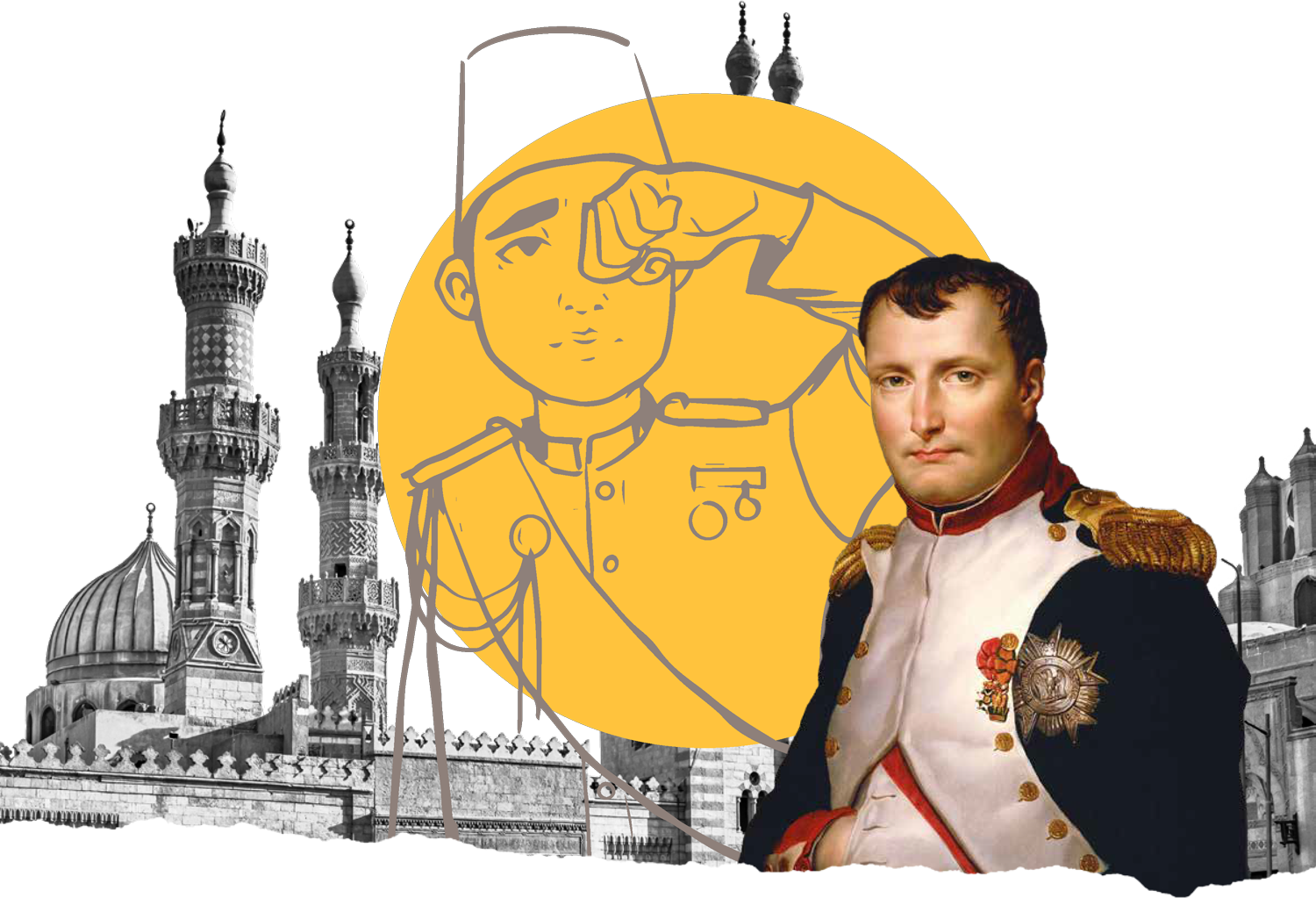
حاولوا تحسين صورة عبدالحميد ونشأته
الذين مدحوه خذلهم بمذكراته
عبدالحميد الثاني هو ابن السلطان عبدالمجيد، كانت مدة سلطنة والده 22 سنة ونصف، وهو الذي أنشأ النيشان المجيدي العلي الشأن وقدمه على نيشان الافتخار الذي أسسه السلطان محمود الثاني، ويتزامن تاريخ حكمه بفترة حكم الوالي محمد علي باشا في مصر، وهذا مما أثر في نشأة عبدالحميد ونظرته تجاه مصر خلال سلطنته.
ولعبد المجيد 26 من الأبناء، يحتل عبدالحميد الترتيب الثاني بعد أخيه مراد، ولكل منهما أم مختلفة عن الأخرى. وقد نشأ عبدالحميد منزويًا، ويشعر بالراحة والمتعة في انطوائه، يعلل ذلك بقوله: “إن الانسان ينشأ تحت تأثير الظروف التي هو فيها”. ومقولته تدل على مدى اعتلاله النفسي للقيود التي تُفرض على مثل هذه النوعية من الأبناء، ليكون إعدادهم إعدادًا مختلفًا يخرج عن الطبيعة الإنسانية إلى التكلف والتعالي في التعامل مع كل من حولهم.
كتب عنه بعض الباحثين بأنه شخصية خجولة، وهذا ليس بمستغرب إن كان منزويًا لأسباب كثيرة، منها كثرة إخوته من وجهة نظره، لأنهم كانوا يعيشون بحرية وانطلاق واهتمام، بينما عامله والده معاملة قاسية سيئة، والسؤال الذي يرد هنا إذا كان السلطان عبدالمجيد يُعد ابنه عبدالحميد للسلطنة فما السبب في تركيزه عليه بينما كان المرشح الأول لولاية العهد هو أخاه مراد الخامس، لم يلاقِ ما لاقاه عبدالحميد!! ويذكر السلطان في مذكراته بأن العطف الوحيد الذي تلقاه كان من أخيه مراد، لكنه يصف أخاه بأنه مسكين.
شعر بحرمان طفولته لأن معاملته كانت جدية، وتلك طبيعة التربية التركية والبيت العثماني وما اتسم به من تعالي حتى على بعضهم البعض.
يؤكد بنفسه أنه لم يكن يهوى اللعب طفلاً…
وكانت طبيعة التعليم التي يتلقاها أبناء السلاطين لها أهميتها، لكنه حُرم منها أيضًا، حتى أن أساتذته كانوا يزجرونه لعدم انضباطه واهتمامه أثناء التعليم، ويعلل هو ذلك بنفسه في مذكراته وأكدها بعضٌ من المؤرخين بأنه كان يعشق العُزلة بعيدًا عن كل ما يحيط به لأنه غير مقتنع بكل الناس من حوله لشعوره بمخالفته لأفكاره. ولكن هنالك من ينفي عنه تلك النشأة وأنه غير مقبول أن يكون فاقدًا لفرصة التعليم ففاقد الشيء لا يعطيه، وأماني الغازي تذكر بأنه قد اهتم بالتعليم وإصلاحاته تشهد له بذلك عندما اعتلى السلطنة، ولو لم يكن متعلمًا فلن يبادر بالإصلاحات العلمية، بينما هناك من كانوا أسوأ منه من السلاطين والحكام وعملوا على إدخال إصلاحات وتغيير عندما نالوا فرصة الحكم. ومن جهة أخرى كانت له فرصة مرافقة عمه السلطان عبدالعزيز في رحلته إلى فرنسا سنة (1867م)، لذلك تأثر بالتقدم الفرنسي عن دولتهم، لذلك عمل على الاهتمام بالتعليم.
ذكر عبدالحميد في مذكراته بأن ارتفاع عدد المدارس الخاصة جلبت الاستثمار الخارجي، وهو ما كان يسعى إليه في إسطنبول، وكتب أن نموذج الأزهر أمامه يجعله حريصًا على أن يعمل مركزًا دينيًّا ليجلب طالبي العلم لعاصمة دولته، وأن معاهد إسطنبول لا بد أن تعمل على تخريج علماء بإعداد مناهج على مستوى عالٍ ليتخرج منها مهندسون ومعماريون وفنيون، وهذا ما ذُكر في انبهاره بأوروبا وتقليدها، كما انبهر بالحياة الأوروبية بكل ما فيها من معيشة غريبة وأخلاقيات مختلفة وشكليات، ثم يتخبط في التوثيق لسياسته بأنه يريد أن يسحب خريجي الأزهر إلى دولته، متناسيًا أن العرب المسلمين يختلفون عن توجهات العثمانيين العقدية والسياسية، لا سيما أن السلطان له فكره الخاص منذ الصغر ترعرع معه إلى أن شب وأصبح سلطان دولةٍ متعالية رغم تأخرها.
مما يثير الانتباه إعجاب عبدالحميد بشخصية نابليون، رغم أن نابليون كان يمارس ضغوطًا على عمه السلطان عبدالعزيز، وتلك الزيارة انعكست على طبيعة حكم عبدالحميد فيما بعد.
كما كان عبدالحميد عديم الثقة بمن حوله منذ الصغر، وهو الأمر الذي ارتسم على شخصيته عندما تولى مقاليد الحكم والسيطرة، إذ لم يكن على وفاق أو اتفاق مع أحد، ولم يكن يثق حتى بنفسه، وانعكس ذلك على تردده وتخبطه في اتخاذ القرارات حينما تولى زمام الأمور.
أعجب بنابليون رغم نظرته الدونية للعثمانية وسلطانها.

واعترف عبدالحميد أنه فاقد للحب والعطف، ويحاول أن يحاكي عُقدة النقص التي كان يعاني منها، لذلك فقد معانٍ مهمة في حياته أثرت عليه بعد الكِبر، وارتسم ذلك وبدا في قسوته واللامبالاة التي كانت واضحة في شخصيته، خاصةً مع تقدمه في العمر.
وتذكر الباحثة أماني الغازي أن والدة عبدالحميد أحاطته بحبها ورعايتها، ونما أسرع من أترابه على حد وصفها، ولم تتوقف عن تغذيته روحيًّا وأخلاقيًّا، فبلغ ذكيًّا فطنًا، إلى أن ذكرت أنه فقد والدته ولكن والده أعاد له توازنه النفسي بعد فقدها برعايته له، وأنه كلف إحدى زوجاته التي لم تنجب برعايته. بينما من يقرأ مذكرات عبدالحميد نفسه سيكتشف عكس ذلك تمامًا، حينما تحدث عن عزلته وانزوائه وقسوة والده معه. لذلك من كتبوا في مديح عبدالحميد وحاولوا تحسين صورته، خذلتهم مذكراته الشخصية التي كتبها بقلمه.
ومن الأحوال التي أثَّرت على تكوينه الشخصي ونفسيته معًا تسلط الوزراء واستبدادهم واشتداد سياستهم في التعامل معه منذ زمن سلطنة عمه عبدالعزيز، وقد اشتكى حاله عندما كتب عن مدحت باشا بعد إعلان الدستور سنة (1876م) إذ يقول عبدالحميد: “ولقد وجدت مدحت باشا ينصّب نفسه آمراً ووصيًا علي، وكان في معاملته بعيدًا عن المشروطية – الديمقراطية – وأقرب إلى الاستبداد”. وهذا مما يبين ضعف شخصيته الشديد وعدم قدرته على المواجهة الطبيعية مع من حوله، إذ انعكس ذلك على معاملته اللاحقة بعد أن تولى زمام الأمر، وبدأ يتعامل مع الجميع بدكتاتورية وعدم ثقة وإرهاب.
ومما عُرف عنه أيضًا تعلقه بالصوفية عندما استهدف طرقها لكسب ولائها للدولة العثمانية والدعوة لفكرة الجامعة الإسلامية، وجعل عبدالحميد من عاصمة دولته إسطنبول مقرًّا ورابطة تربط بين الدولة والتكايا ومراكز تجمع الطرق الصوفية في كل أنحاء العالم الإسلامي، واتخذ منهم دعاة للدعاية للجامعة الإسلامية، وتكونت بذلك لجنة مركزية، مكونة من العلماء وشيوخ الطرق الصوفية حيث عملوا مستشارين للسلطان في شؤون الجامعة الإسلامية التي كان يطمح أن تكتسح العالم بفكرها وشعارها “يا مسلمي العالم اتحدوا” الشعار الذي كان الهدف منه إنقاذ الدولة العثمانية من الانهيار والسقوط.
عُقد النقص والاعتلال ظهرت في سياسته حينما أصبح سلطانًا.

كان عبدالحميد سيئًا في تدبير الاقتصاد رغم شحه وبخله، وقد أكد ذلك في مذكراته، بأنه جمع أموالاً طائلة استودعها خارج بلاده في البنوك الألمانية العثمانية للاستثمار باعتبارها مكانًا أمينًا جداً لصالحه الشخصي، لأن إسطنبول لا تملك مصرفًا يمكن الاعتماد عليه، ذلك على عكس من سبقوه، وكل ما جُمع من ضرائب أرهقت الناس كان يحول عبدالحميد ما يخصه إلى تلك الأرصدة الخارجية. كما كان عبدالحميد مولعًا بالتجارة، التي شُغِف بها على أيام والده عبدالمجيد الأول، وعلى الرغم من ذلك لم يكن بارعًا فيها.






