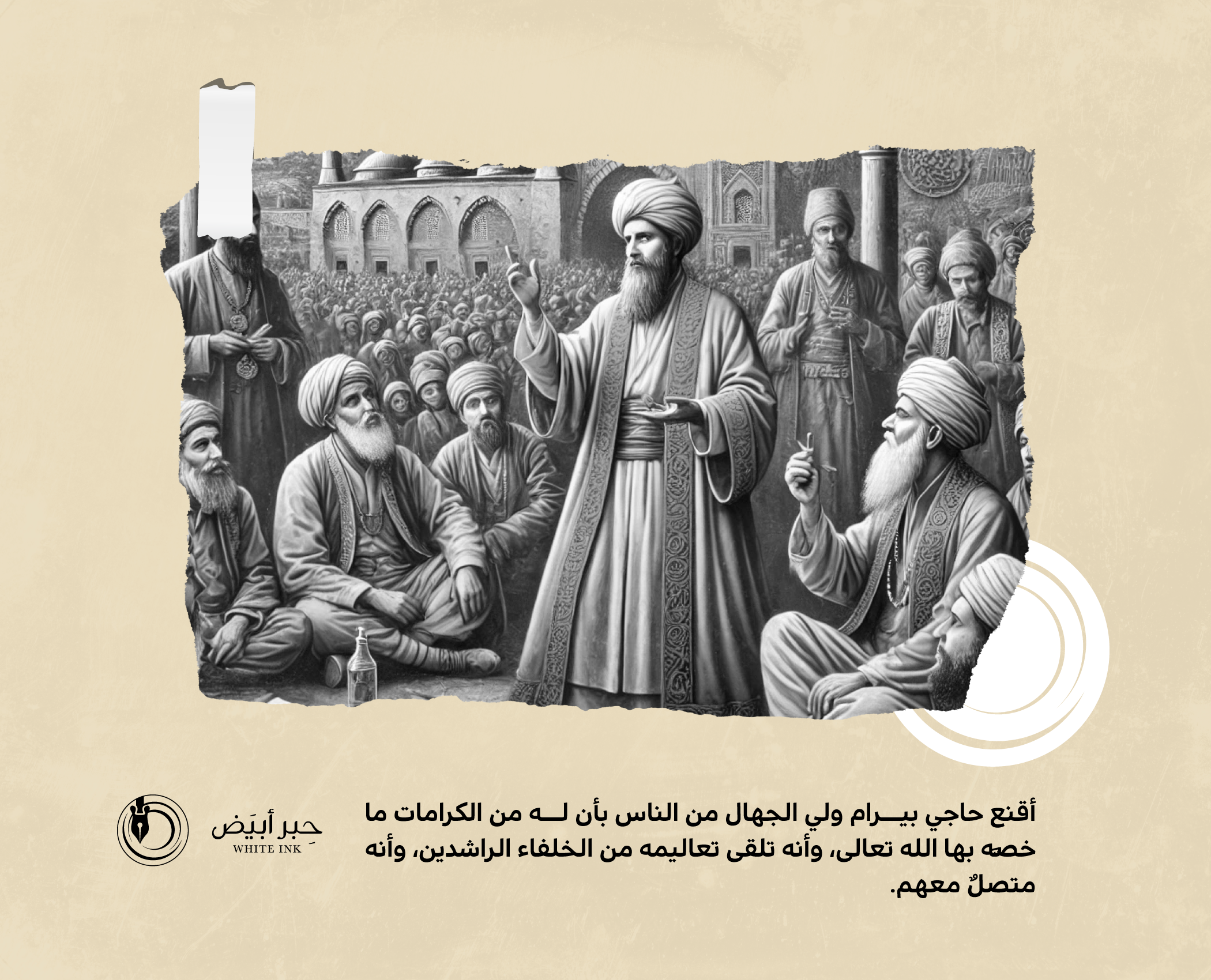تأثيرات الفرق الدينية
في الفكر العثماني وانحرافاتها العقائدية
في تاريخ الدولة العثمانية، لعبت الطرق الدينية وأفكارها المتعددة دورًا كبيرًا ليس فقط في شؤون الدين بل وفي السياسة والإدارة العامة للدولة. ومن ذلك أن استطاعت الصوفية أن تبني جسورًا بين الحكم والشعب، ولكن في المقابل، أثروا في توجيه العقائد بطرق لا تتماشى مع النهج الديني الصحيح.
كان للطرق الدينية المتعددة في الدولة العثمانية خدمة للسلاطين لتخادمها من تحقيق مصالحهم السياسية.

الدولة العثمانية، منذ نشأتها، كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالطرق الصوفية. وبالنظر إلى أن الأتراك العثمانيين نشأوا في بيئة تحتضن الصوفية بشكل كبير، فقد وجدوا في هذه الطرق الدينية الدعم الروحي والاجتماعي الذي كانوا بحاجة إليه لتأسيس دولتهم. فتأثير الطريقة البكتاشية، على سبيل المثال، كان لافتًا في الجيش العثماني، حيث أصبحت طقوسها وتعاليمها جزءًا من الحياة اليومية للجنود، ومن ثم انتقلت إلى السلطة العليا في الدولة. هذا على الرغم مما في البكتاشية من شطط وخزعبلات لا علاقة لها بالدين، إضافةً إلى توجهاتها ومنطلقاتها الباطنية.
وخلال التاريخ العثماني، قدم سلاطين الدولة دعمًا كبيرًا للطرق الصوفية، لاسيما تلك التي أظهرت ولاءً وتأييدًا للنظام السلطاني. ومع ذلك، هذا الدعم لم يكن مجرد عطاء بلا مقابل؛ بل كان يهدف إلى استخدام النفوذ الروحي للصوفية لتعزيز السلطة السياسية وتوطيد الحكم. من جهة أخرى، أدى هذا التداخل بين السلطة الدينية والسياسية إلى انحرافات في المعتقدات، حيث استُغلت بعض المفاهيم الصوفية لخدمة أهداف سياسية ضيقة، مما أثر سلبًا على البنية الفكرية للمجتمع العثماني.
التصوف، بطبيعته، يركز على البحث الروحي العميق، وفي البيئة العثمانية، بدأت بعض الطرق الصوفية في تبني ممارسات ومعتقدات قد تصل إلى حد الغلو والشرك بالله عز وجل. هذا الانحراف جاء نتيجة للتأثيرات السياسية والطموحات الشخصية لبعض الشيوخ الذين استغلوا نفوذهم لنسج تعاليم لا تمت للتصوف الحقيقي بصلة.
العقائد الصوفية في الدولة العثمانية ساهمت في تأسيس نظام حكم يمزج بين الديني والسياسي بطرق لم تكن في صالح الدين. لذلك، من المهم دراسة هذه التأثيرات بعمق لفهم كيف ساهمت الصوفية في شكل الدولة العثمانية وتأثيرها على المعتقدات والممارسات الدينية خلال عصرها.
وقد وصلت الطرق الصوفية في الدولة العثمانية إلى أن أصبحت جزءًا من تقاليد الحكم والسلطنة، وشكلت السياسات العامة والقرارات الاستراتيجية. وعلى سبيل المثال، السلطان سليم الأول كان معروفًا بتعاطفه الشديد مع الطريقة البكتاشية، وهي طريقة تعتمد على مبادئ العقيدة الباطنية الاثناعشرية، على الرغم من أن الدولة العثمانية كانت تعتنق المذهب السني الحنفي، إلا أن تأثير البكتاشية كان واضحًا في الجيش الإنكشاري، الذي كان يشكل قوة عسكرية رئيسية في الإمبراطورية.
الصوفية كانت جزءًا من الفكر العثماني بتحولاته الدينية والثقافية التي شهدتها الدولة عبر تاريخها. فالممارسات والتعاليم الصوفية أدت إلى انحرافات العثمانيين عن المذهب السني، الذي كان يُعتبر المذهب الرسمي للدولة. فقد دعم العثمانيون التأويل الداخلي والبحث عن معاني أعمق في النصوص الدينية، وهو ما يتعارض مع التفسيرات الفقهية الدينية الموثوقة. هذا النهج أدى إلى ممارسات وتفسيرات غير تقليدية تتعلق بالعبادات والشريعة، مما أثار قلق العلماء الذين كانوا يحرصون على الالتزام بالمنهج الفقهي الصارم. ومن ذلك تزكية النفس والتصفية الروحية، وهو ما يُنظر إليه على أنه يتجاوز الفقه الإسلامي العملي بالتركيز على البُعد الروحي المؤدي إلى إغفال الجوانب الشرعية الإسلامية.
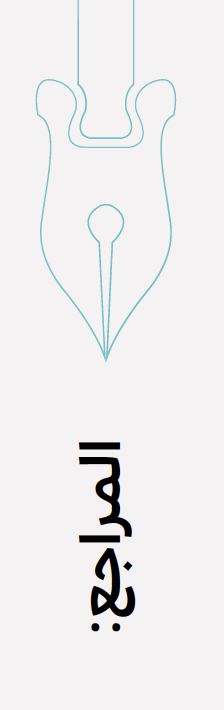
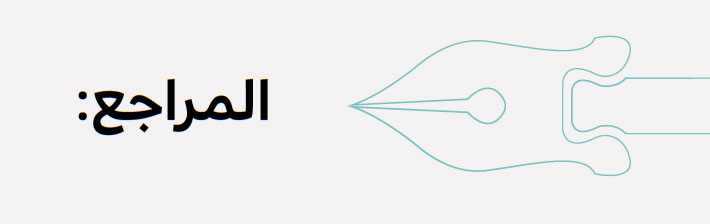
- أحمد شقيرات، تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني 1425-1922 (إربد: دار الكندي، 2002).
- محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي (بيروت: دار النفائس، 1981).
- محمد النفزاوي، التيارات الفكرية السياسية في السلطنة العثمانية 1839-1918 (صفاقس: دار محمد الحامي، 2001).

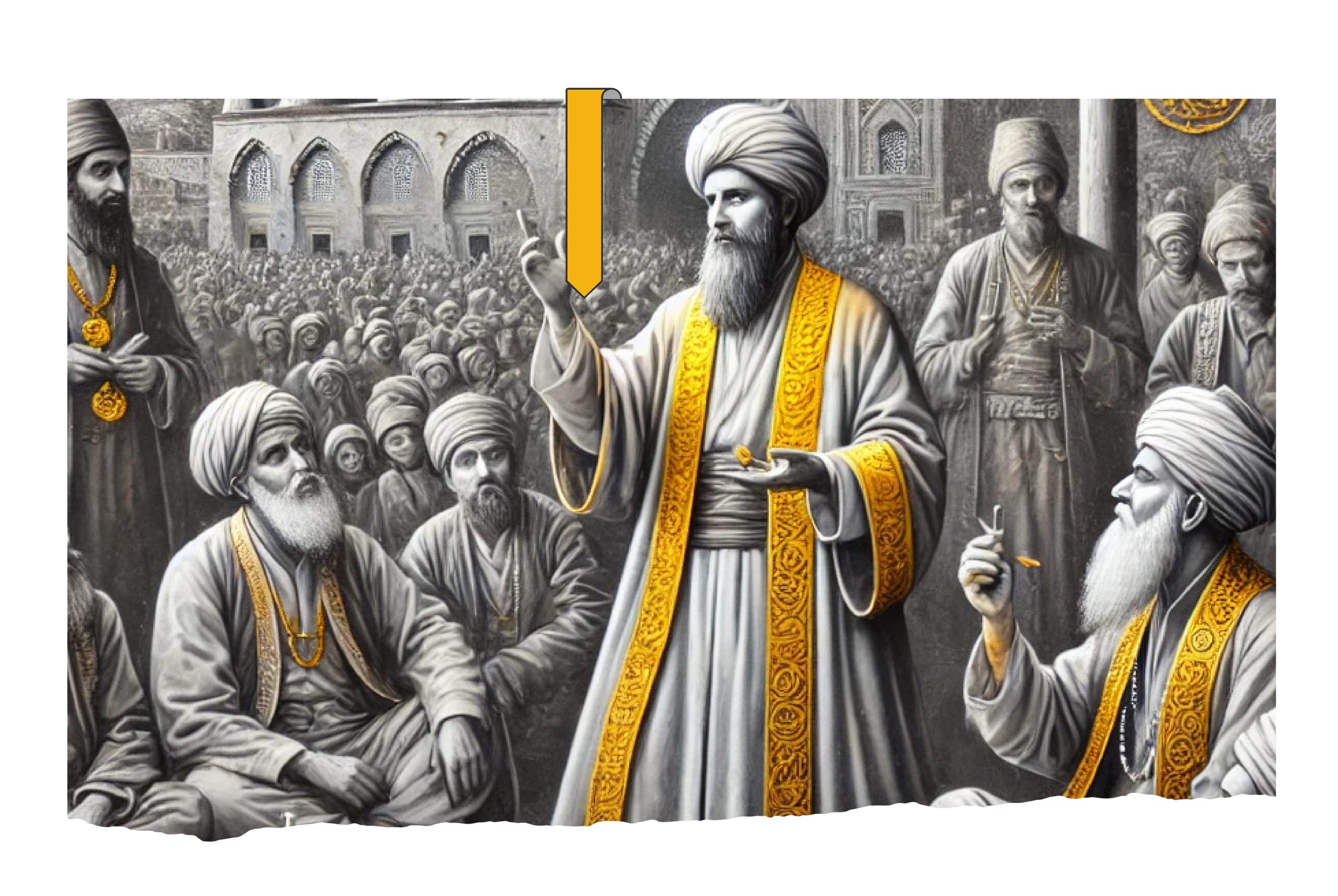
البيرامية:
تأثيرها التاريخي في الإسلام العثماني
العقيدة البيرامية، وبالرغم من كونها غير مشهورة، لكنها ذات تأثير كبير في أواسط آسيا وشرق أوروبا المسلم، إذ تكاد تجمع المصادر على أنها فرقة متطرفة تُنسب لمؤسسها حاجي بيرام ولي، وتشتق من الخلوتية، ويدعي أتباعها أنه قد عُهِد إلى الخليفة أبي بكر رضي الله عنه بالذكر الخفي، وإلى الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالذكر الجلي.
مرحلة من التحولات العقائدية والصراع الروحي في الفكر العثماني.

اكتسبت البيرامية شهرتها من اتباع محمد الفاتح لها في بداية حياته، حتى تم فتح القسطنطينية، إذ تشير المصادر إلى انتقاله لحب المسيحية وتولعه بها، لقد تنقل الفاتح بين العقائد في أطوار عمره المختلفة. وتخص البيرامية أتباعها بالذكر الخفي، وبعد وفاة مؤسسها انقسمت إلى بيرامية شمسية وبيرامية ملامتية. فالأولى أخذت بالذكر الجلي، والثانية اتبعوا الملامتية وهجروا الذكر والورد وتكاياهم، وفلسفتهم تحريم إظهار التقوى، والمبتدئ في البيرامية يمارس العبادة على أساس توحيد الأفعال أو فنائها في فعل الله، باعتبار أنها جميعًا من عند الله، فليس العبد هو الفاعل، وإنما الفاعل الحقيقي هو الله، ثم تأتي المرحلة التي يفهم فيها أن الأفعال هي كشف لصفاته، وتلك الصفات أو فنائها في صفات الله، ثم تأتي المرحلة الأخيرة والتي يفهم فيها أن الصفات قد فنيت في صفات الله، ولم يعد غير صفات الحق التي هي تجلياته لذاته فإن الوجود يصبح في حقيقته واحدًا وهذه هي مرحلة توحيد الذات، أو فناء كل الذوات في ذات الله تعالى.
يرى البعض أنّ الطريقة البَيراميّة جمعت بين الطريقتين النقشبندية والخلوتية، وقالوا إنّها لهذا السبب تعتقد بالذكر الخفي تقليدًا للنقشبندي، وأيضًا بالذكر الجلي تقليدًا للخلوتية. علاقة محمد الفاتح بالعقيدة البيرامية؛ بسبب علاقته الوثيقة بمعلمه آق شمس الدين، حيث وثق الفاتح في معلمه الذي تبارك به واعتبره من الخارقين، فاتسع نطاق تلك الطريقة حتى أنها طغت تمامًا على العبادة في الولايات الغربية للسلطنة العثمانية، خاصة البوسنة والهرسك وشوهتها وحولتها إلى طقوس لا علاقة لها بالإسلام الصحيح، ويقول فهمي هويدي في دراسة منشورة كتاب جامع الكتب الإسلامية فصل (الطرق الصوفية وانتشار البدع): “إن الطرق الصوفية قد استفحلت في بعض مناطق يوغسلافيا، وشوَّهت تعاليم الإسلام. وليس أمام المسلمين هناك قنوات شرعية لتوصيل الدين الصحيح إليهم، فتصور عامة المسلمين أن الدين هو هذه الطريقة أو تلك، أما أئمة المساجد فدورهم محدود، حيث إن الإمام يقول كلمته مرة كل أسبوع، والناس يعيشون في عالم آخر يرفض الدين، ويجرح تعاليمه الأساسية بقية الأسبوع”. وفي كتاب السلالة البكرية الصديقية لأحمد فرغلي الدعباسي البكري، ذُكر أن آق شمس الدين درَّس محمد الفاتح عددًا من العلوم، ومنها الجريقية البيريمية، وورد فيه أن لـ آق شمس الدين كرامات قربته من السلطان محمد الفاتح.
لم تتوقف كرامات “آق” عند ذلك بل زعموا أنه أخبر السلطان أنه من سيفتح القسطنطينية، وأنه المقصود بالحديث الشريف – غير الصحيح في أساسه -، وأنه هو من عرف مكان قبر الصحابي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي كان مجهولًا لأكثر من 800 سنة حتى جاء آق شمس الدين وعرفه ووضع عليه بأمر محمد الفاتح ضريحًا.
هكذا انغمس الفاتح في البيرامية وطريقتها العقائدية وأفكار ونشرها، ومن أبرز سمات البيرامية التي عرفت عنها، شدة الإيمان بوحدة الوجود، إذ تعرف ذلك بأن الإيمان القلبي بوحدة الوجود مرحلةٌ يمكن الوصول إليها في نهاية السلوك؛ في حين أنّ السالك في البَرياميّة يبدأ سلوكه بالأيمان بوحدة الوجود، ويسعى لتحقيق هذا الإيمان في نفسه. وقد عدّ “بيرام الولي” وهو مؤسس الطريقة المراتب الثلاثة الموصلة إلى التوحيد حسب طريقته كالتالي: العلم “بيلمك”، الإيجاد “بولماق” والصيرورة “أولماق”، وقد وردت هذه المراتب في الرسالة النورية ومقامات الأولياء لـ “آق شمس الدين” معلم محمد الفاتح.
وبسبب الدعم الكبير وإيمان محمد الفاتح بهذه الطريقة انتشرت البَيرامية في ضواحي أنقرة، وإسطنبول، وأدميت، وبويل، وبورصة، وأضَنة، ومرعش، وقَسْطَموني. وبُني لها ما يُسمى خانقاهات، أو التكايا البيرامية.
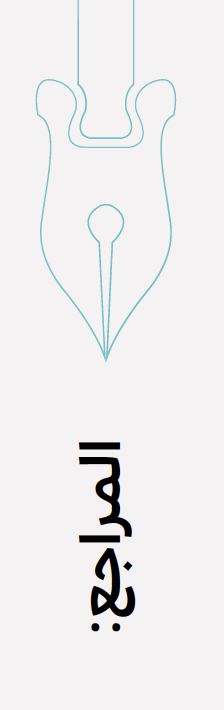
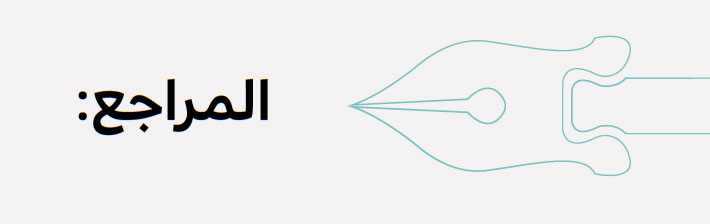
- أحمد القصير، عقيدة الصوفية ووحدة الوجود الخفية (الرياض: مكتبة الرشد، 2003).
- عبدالمنعم الحفني، موســـوعة الفــــــرق والجمـاعـــــات والمذاهب والأحزاب والتنظيمات والحركات (القاهرة: مكتبة مدبولي، د.ت).
- نيكلسون، الصوفية في الإسلام، ترجمة: نورالدين شريبه، ط2 (القاهرة: مكتبة الخانجي، 2002).