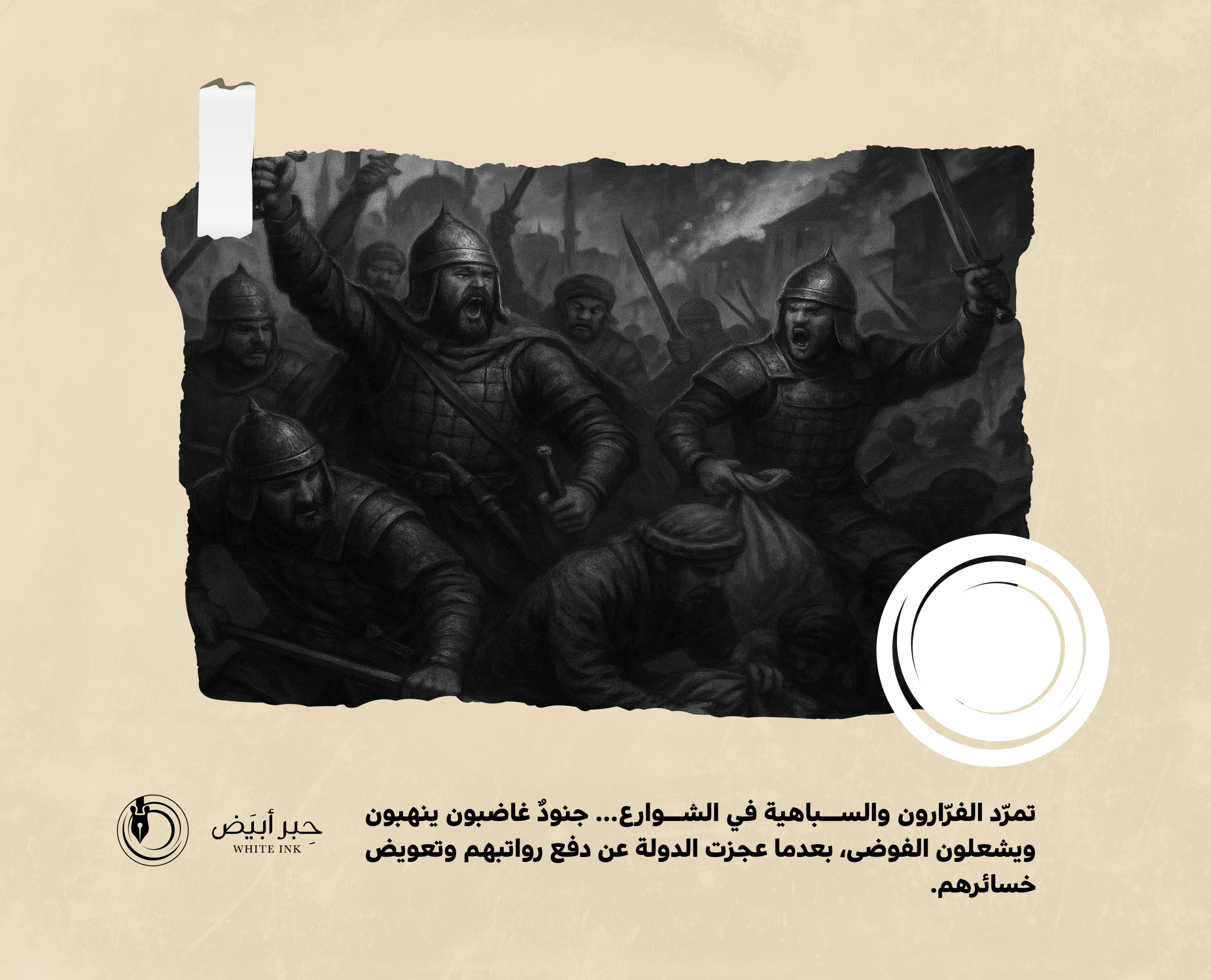السلطان المُعتلّ:
محمد الثالث بين سفك الدماء وفوضى الحكم
منذ بدايات الدولة العثمانية، وخصوصًا مع اتساع رقعتها الجغرافية وتنوع شعوبها، برزت مشكلة جوهرية تهدد العرش: صراعات الوراثة بين أبناء السلطان. كان الحل التقليدي في دول المشرق الإسلامي يتمثل في تقسيم الملك أو تغليب الأقوى عسكريًا، مما يؤدي إلى حروب طاحنة. أما العثمانيون فابتكروا ما اعتبروه حلاً وقائيًا؛ وهو قتل الإخوة الذكور للسلطان الجديد فور اعتلائه العرش. تحوّل هذا السلوك الوحشي إلى ما يشبه القانون العرفي غير المكتوب، ثم جرى تقنينه في عهد محمد الفاتح تحت مبدأ درء الفتنة عن الدولة. وهكذا صارت السلطنة تُفتتح عادة بمجزرة أسرية، يتكرر مشهدها جيلاً بعد جيل.
قتل إخوته وابنه.. وحوَّل قصر السلطنة إلى كهف من الكآبة والدموية.

محمد الثالث: نموذج متطرف للقانون الدموي
في هذا السياق نسلط الضوء على حكم محمد الثالث (1595–1603)، الذي اعتلى العرش في سن الثامنة والعشرين، ولم يكن يملك من الخبرة أو الكفاءة ما يضمن له السيطرة على الدولة، فاعتمد على أسهل وسيلة رسّخها أسلافه: القتل الجماعي لإخوته. حيث أعدم السلطان الجديد تسعة عشر أخًا في يوم واحد. مشهد كابوسي لا مثيل له في تاريخ البلاطات الإسلامية، إذ لم يكونوا مجرد أسماء على الورق، بل أطفال ومراهقون يعيشون معه في القصر، يمرحون تحت سقف واحد، ثم سيقوا جميعًا إلى المقابر بقرار سلطاني بارد. هذا السلوك الدموي لم يكن شذوذًا فرديًا، بل تجسيدًا متطرفًا لقاعدة عثمانية صارت شرطًا للبقاء في الحكم. وإذا كان أبوه مراد الثالث قد افتتح حكمه بقتل خمسة من إخوته، فإن محمد الثالث بالغ في تطبيق القاعدة حتى بلغت ذروتها.
لم يتوقف محمد الثالث عند حد الإخوة. بل اختتم عهده بجريمة أبشع من حيث الرمز: قتل ابنه وولي عهده الأمير محمود. تعلّلت الجريمة بشائعة عن انقلاب يعدّه الفتى الذي لم يتجاوز السادسة عشرة. صدّق السلطان الشائعة، وزاد الطين بلة أن السلطانة صفية –والدة السلطان– كانت طرفًا في المؤامرة، لما بينهما من صراع مع والدة الأمير محمود، ورغبتها في إقصائه عن وراثة العرش. فأمر السلطان بقتله، ثم دخل غرفته ليتأكد من خروج روحه. هكذا دارت دورة الدم كاملة: بدأ محمد الثالث حكمه بقتل إخوته، وختمه بقتل ابنه.
مقارنات تاريخية: بين محمد الثالث وأسلافه
- محمد الفاتح (1451-1481): أول من رسّخ “قانون قتل الإخوة” بصياغة شبه رسمية، إذ نصّ في “قانون نامة” على جواز قتل الإخوة درءًا للفتنة. وبذلك أعطى الغطاء الشرعي لما صار لاحقًا عرفًا ثابتًا.
- سليم الأول (1512-1520): قتل إخوته وأبناءهم فور اعتلائه العرش، لكنه برز بإنجازاته العسكرية التي غطّت على دموية بدايات حكمه.
- مراد الثالث (1574-1595): والد محمد الثالث، افتتح عهده بقتل خمسة من إخوته. لكنه ترك لابنه إرثًا ثقيلًا من الفساد الإداري والاعتماد على الجواري.
- محمد الثالث (1595-1603): تفوق على الجميع في وحشيته: قتل تسعة عشر أخًا وابنه، ولم يُعرف عنه إنجاز يبرر هذا العنف، بل اقترن اسمه بالفوضى والضعف.
من هذه المقارنة يظهر أن قتل الإخوة كان “ضرورة سياسية” في نظر العثمانيين، لكنه مع محمد الثالث تحوّل إلى عبث دموي بلا مقابل. فإذا كان بعض أسلافه قد عُرفوا بالفتوحات أو الإصلاحات، فإن محمد الثالث لم يترك إلا سجلًا أسودًا يُعرف به تاريخه.
البعد الاجتماعي والنفسي لظاهرة قتل الإخوة
هذا التقليد لم يكن مجرد إجراء سياسي، بل خلّف آثارًا عميقة، تمثلت بثقافة الخوف في القصر، حيث نشأ الأمراء العثمانيون في أجواء من الرعب والترقب، يعلمون أن مصيرهم عند موت والدهم قد يكون الموت. وهذا أنتج أجيالًا من السلاطين المعزولين، يفتقدون الاستقرار النفسي. كما ساهم في إضعاف الرابطة الأسرية، فبدلاً من أن تكون الأسرة الحاكمة وحدةً متماسكة، صارت بؤرة صراع ومجازر. إضافةً إلى انعكاس الأمر على الرعية، إذا كان السلطان لا يتورع عن قتل إخوته وأبنائه، فكيف يُنتظر منه رحمة بالرعية؟ وهكذا صار العنف جزءًا من صورة الدولة.
فوضى الإدارة وحكم الجواري
لم تكن دموية محمد الثالث سوى وجه واحد لأزمته. الوجه الآخر هو الفوضى الإدارية. ففي عهده انهارت قيمة العملة، وبيعت المناصب، وتكررت الهزائم العسكرية، واندلعت الثورات حتى وصلت إلى إسطنبول. وعجزت الدولة عن دفع رواتب الجنود، فانقلبوا إلى النهب والفوضى. وفي ظل انشغال السلطان بملذاته، برزت السلطانة صفية كحاكم فعلي. أغرقت ابنها بالجواري لتصرفه عن شؤون الدولة، بينما أدارت هي الجهاز الإداري والسياسي. وتحوّل القصر إلى ساحة نفوذ نسائي متشابك، يُعرف في التاريخ العثماني بمرحلة سلطنة الحريم.
خلاصة: منطق الحكم المريض
تجربة محمد الثالث تكشف عن جوهر الأزمة في السلطنة العثمانية، المتمثلة بقانون قتل الإخوة الذي بدأ كحل لتفادي الفتنة، وانتهى ليصبح أداة للدموية والعبث. والفساد الإداري الذي أفرغ الدولة من قوتها، وحوّل الجيش إلى عصابة مرتزقة، كما أن تحكم الجواري في القصر حوّل مركز القرار إلى شبكة من المؤامرات الشخصية. فهكذا اجتمعت في شخص محمد الثالث كل معالم الانحدار العثماني: منطق العرش يبدأ بقتل الإخوة، وينتهي بفوضى تُدار من وراء ستائر الحريم.
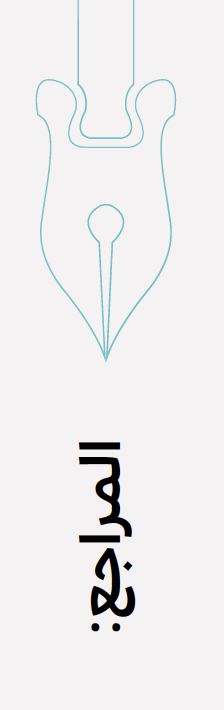
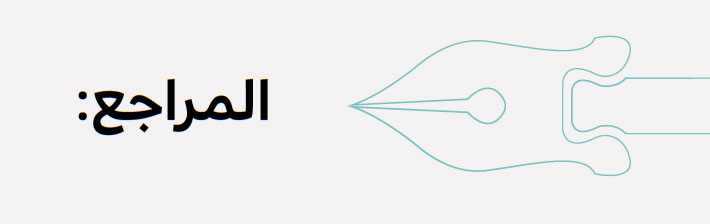
- أحمد آق وسعيد أوزتوك، الدولة العثمانية المجهولة (إسطنبول: وقف البحوث العلمية، 2014).
- ألبير أورتايلي، إعادة استكشاف العثمانيين، ترجمة: بسام شيحا (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2009).
- عبدالعزيز الشناوي، الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها (القاهرة: مكتبة الأنجلو، 1980).
- محمد صوان، يوميات السلطان: الحوادث الهامة في تاريخ الدولة العثمانية ودلالاتها (الجزائر: دار الروافد، 2020).
- محمد فريد بك، تاريخ الدَّولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي (بيروت: دار النفائس، 1983).


فوضى العهد السلطاني:
محمد الثالث بين تمرّد الجند وثورة الجلالية
تولّى محمد الثالث، السلطان العثماني الثالث عشر، العرش سنة (1595) بعد وفاة والده مراد الثالث، وكان قد قضى سنواتٍ واليًا. وقد استهل حكمه بمجزرة أسرية معتادة في البيت العثماني، إذ قتل تسعة عشر من إخوته الذكور دفعة واحدة، توطيدًا لسلطانه. وهكذا بدأ عهده على الدم، لكنه سرعان ما واجه واقعًا أشد دموية: دولة منهكة، وجيش ممزق، وثوراتٌ متلاحقة في الداخل.
• حين تحوّل السلطان إلى شاهدٍ على انحلال سلطانه

ترك السلطان الشاب إدارة الدولة لوزرائه، فانغمس هو في القصر وشهواته، فيما تقاسم الوزراء النفوذ، وباعوا المناصب، وتلاعبوا بالعملة. سرعان ما انعكس هذا على هيبة الدولة في الداخل والخارج. وحين نصحه بعض العلماء بتولّي قيادة الجيوش بنفسه، خرج بالفعل إلى ساحات القتال، لكنه اصطدم بواقع مرير: جيش أنهكه التحاسد، وقيادة عاجزة عن ضبط الجنود. كانت معركة كرزت (1596) مع التحالف النمساوي–المجري محطة فاصلة؛ انتصر فيها العثمانيون بالكاد، لكن الجيش خرج ضعيفًا مفككًا، وعاد الجنود ممتلئين بالضغينة والتمرّد.
شهد عهد محمد الثالث تمرّدين بارزين؛ الأول ثورة الفرّارين، وهم الجنود الذين فرّوا من معركة كرزت. قرر السلطان نفيهم إلى الأناضول، لكنهم تمرّدوا أكثر من مرة، فصاروا نواة لعصيانٍ دائم. والثاني ثورة السباهية (الخيالة)، وهم فرسان الجيش العثماني الذين تمتعوا بإقطاعاتٍ تُعفيهم من الضرائب مقابل الخدمة. لكن الدولة عجزت عن تعويضهم بعد اضطراب الأناضول، فثاروا في إسطنبول ومصر، معلنين غضبهم على السلطان الضعيف.
كان لمحمد الثالث ثلاثة أبناء: سليم، توفي صغيرًا، ومحمود، الذي أعدمه أبوه سنة (1603) خوفًا من انقلاب مزعوم، ثم أحمد الذي ورث العرش وعمره أربعة عشر عامًا فقط. ومع أن محمد الثالث أبقى أخاه مصطفى حيًا، إلا أنه حبسه مع الجواري والخدم، لتكون “العزلة” بديلًا عن “القتل”. وهكذا استمر منطق البيت العثماني في التخلص من الأقرباء: إمّا القتل وإمّا الحجز.
الأخطر في عهد محمد الثالث لم يكن تمرّد الجند وحده، بل انفجار الأوضاع الاجتماعية في الأناضول فيما عُرف بـ الثورة الجلالية، التي تعود جذور تسميتها إلى ثورةٍ سابقة قادها الشيخ جلال في أوائل القرن السادس عشر ضد السلطان سليم الأول. ومنذ ذلك الحين صار اسم “جلالي” يطلق على كل حركة تمرّد في الأناضول. وكانت أسباب الثورة:
- الضرائب الباهظة التي فرضتها الدولة على الفلاحين لتعويض خسائرها وتراجع عائدات التجارة بعد تحولات المسالك البحرية العالمية.
- الأزمة الاقتصادية بتراجع الغنائم العسكرية، وانهيار موارد الدولة، فزاد الضغط على العامة.
- انحلال الجهاز الإداري، فالموظفون والجنود صاروا يعوضون نقص رواتبهم بمصادرة أملاك الفلاحين وزيادة الضرائب ظلمًا.
- تفاقم البطالة، حتى دُفع الفلاحون إلى ترك أراضيهم والهجرة للمدن، فتفاقمت الأزمة الغذائية.
خلال ذلك برز قره يازيجي، “الكاتب الأسود”، قائدًا خطيرًا للثورة. رفض تسليم منصبه لوكيل الدولة الجديد، فبدأ تمرّده الذي سرعان ما تحول إلى حركة مسلحة ضخمة. أعلن نفسه سلطانًا على الأناضول، ولقّب نفسه بـ”المظفر حليم شاه”، وعيّن خصوم الدولة في مناصب عليا. ورغم أن الدولة حاولت قمعه بقيادة حسين باشا، فإن الأخير تواطأ معه، ليُستغل لاحقًا ويُهان في شوارع إسطنبول قبل إعدامه.
انهزم قره يازيجي لاحقًا وقُتل عام (1601)، لكن أخاه ديلي حسن (المجنون) واصل التمرّد، حتى عرضت الدولة عليه ولاية البوسنة مقابل التهدئة.
أخذت الثورة الجلالية طابع “الحرب الأهلية”: قطاع طرق، فلاحون ناقمون، جنود فارّون، وحتى بعض ولاة الأناضول، جميعهم انخرطوا في التمرّد. لم يعد الأهالي يفرّقون بين جابي ضرائب رسمي ولصّ متنكر. وصارت الدولة عاجزة عن ضبط الوضع إلا بمجازر هائلة؛ إذ قُتل عشرات الآلاف، وقيل إن الآبار مُلئت بالجثث.
هنا يمكن قراءة عهد محمد الثالث من خلال ثلاث دوائر متشابكة:
- البيت العثماني: حيث استمرت سياسة القتل والحجز ضد الإخوة والأبناء.
- المؤسسة العسكرية: انقسمت بين فرقٍ مرتزقة (الإنكشارية، السباهية) غير منضبطة، تشعل التمردات عند كل أزمة.
- انهيا المجتمع الأناضولي تحت وطأة الضرائب والظلم، فحوّل أزمته المعيشية إلى ثورة مسلحة.
إنها صورة سلطنة فقدت قدرتها على الضبط الذاتي، وتحول سلطانها إلى مجرد “شاهد على الفوضى”، لا يمتلك من أدوات الحكم إلا الدم، بينما تتهاوى أركان الدولة من الداخل.
انتهى عهد محمد الثالث بعد تسع سنوات فقط، تاركًا لابنه أحمد الأول دولة مثقلة بالتمرّدات والديون. وإذا كان العثمانيون قد اعتادوا أن يبدأ حكم السلطان بقتل أقربائه، فإن عهد محمد الثالث أضاف صفحةً جديدة: الدولة كلها باتت ميدانًا لقتل جماعي، سواء في قصر السلطان أو في ريف الأناضول. لقد جسّد هذا السلطان ما يمكن تسميته بـ “فوضى العهد السلطاني”: حيث العرش لا يضبط الدولة، بل يفاقم تمزقها.