
نهب المقدسات:
الأمانات النبوية بين سطوة الاحتلال العثماني وسوق المتاحف
لم تكن علاقة العثمانيين بالشعوب الإسلامية قائمة على مبدأ الأخوّة أو وحدة المصير، بل كانت تُدار بعقلية السلطان المستبد الذي يرى في تلك الشعوب ممتلكات تابعة، وثرواتها متاحة للتصرف الإمبراطوري كيفما شاء. ومما يثبت هذا المنهج الاستعلائي ما ارتكبوه من جرم تاريخي فادح حين قاموا بنقل النفائس النبوية من الحجرة الشريفة في المسجد النبوي إلى إسطنبول، متجاوزين كل حدود القدسية والاحترام.
فقد تعمّد العثمانيون ترحيل المقتنيات النبوية إلى متحفهم الخاص في قصر “طوب قابي”، دون اعتبار لقدسية الموقع، ولا لحرمة ما نُقل، بل والأدهى من ذلك أنهم تعاملوا مع هذه الأمانات كأنها إرث شخصي يخصهم، يعرضونه للسياح، ويتربحون من عرضها كما تُعرض المقتنيات الإمبراطورية الباذخة. لقد تحول الإرث النبوي إلى سلعة معروضة، يدرّ دخلاً سياحيًا ويُستخدم كرمز سلطوي، وكأنهم يقولون: إن قدسيتنا تُستمد من استحواذنا على أقدس ما لدى المسلمين.
ولم تقف تجاوزاتهم عند الحجرة النبوية، بل تعدوها إلى الكعبة المشرفة، حين أقدموا على انتزاع أجزاء من الحجر الأسود، ونقلوها إلى إسطنبول لتُثبت على شواهد قبور سلاطينهم. لقد كان ذلك الفعل صدمة للمسلمين، ففيه انتهاكٌ سافر بحرمة البيت الحرام، واختطاف لمكوّن رمزي من هوية المسلمين الكبرى، لصالح تمجيد أضرحة زعماء سياسيين لا قيمة لهم في حياة المسلمين المعاصرين.
ويُستدعى في هذا السياق الدور الكارثي الذي لعبه فخري باشا، القائد العسكري العثماني الأخير في المدينة المنورة، إذ لم يكتفِ بنقل الأمانات النبوية إلى إسطنبول، بل ضم إليها زينة المآذن، ومخطوطات نادرة من مكتبات المدينة، وهِلالات المساجد، وكأن المدينة صارت غنيمة حرب لا مكانة مقدسة.
يذكر أحمد حلمي مصطفى في كتابه الغرفة النبوية الشريفة أن “السلطنة العثمانية أصدرت أمرًا بنقل الأمانات المباركة والهدايا المتراكمة على مدى قرون إلى قصر طوب قابي”. ويضيف أن فخري باشا نظّم عملية النقل بإجراءات أمنية مشددة. لكن المشهد لا يُمكن تبسيطه تحت مظلة “الحماية”، فالخطر الأكبر على هذه الأمانات جاء لاحقًا، حين كادت تقع في يد الاحتلال الأوروبي بعد الحرب العالمية الأولى، حين أضحت إسطنبول على وشك السقوط.
قراءة نقدية في مصير نفائس الحجرة الشريفة بين التبرير السياسي والتسليع المتحفي.

ففي لحظة الهزيمة، حين اقتربت القوات البريطانية والفرنسية من العاصمة العثمانية، فكّر العثمانيون جديًّا بنقل تلك النفائس من إسطنبول إلى قونية داخل الأناضول، بحسب ما يذكره حلمي مصطفى، مما يؤكد هشاشة مبرر “الحفاظ”، ويُظهر أن ما حدث لم يكن سوى استيلاء سياسي مغلّف بلغة الحماية.
كما أنهم نقلوا “الكوكب الدري” – وهو أغلى ما في الحجرة الشريفة – مع قطع من الماس ونفائس أخرى إلى إسطنبول، ولم تُعاد حتى اليوم، مما يُثبت أن هدفهم لم يكن مؤقتًا، بل سعيًا دائمًا للاستحواذ الرمزي.
تبرير العثمانيين لهذا السلوك القاسي أن بعض هذه النفائس كان هدية من سلاطينهم، وكأنهم بذلك يملكون حق استردادها متى شاؤوا. وهو تبرير مردود عليه؛ فالهدايا المُهداة إلى الحجرة النبوية لم تكن ملكًا للأشخاص، بل صارت بالنية والمقصد وقفًا دينيًا، لا يجوز التصرف فيه أو إخراجه من موضعه الشريف.
لقد أدرك فخري باشا أن سيطرة المدينة ستعود لأهلها، فاستعجل تنفيذ مخططه الجريء. لم يكتفِ بتجميع النفائس، بل نقلها بقطار دخل به حي العنبرية، واخترق المدينة إلى أن أوصله إلى باب السلام في المسجد النبوي، ليُحمّل الجنود العثمانيون كل ما طالته أيديهم من مقتنيات الحجرة النبوية، وينقلوها إلى حيث لا يجوز أن تكون.
لقد طُبعت هذه الحادثة في الذاكرة الإسلامية كأحد أقسى الشواهد على غياب الاحترام للحرم النبوي، وحرمة المدينة المنورة. لم تكن تلك مقتنيات عادية، بل كانت أمانات معنوية، سُرقت من مكانها الطبيعي، لتوضع خلف زجاج متحف استُخدم لترسيخ سردية السلطنة وادعاءات مجدها.
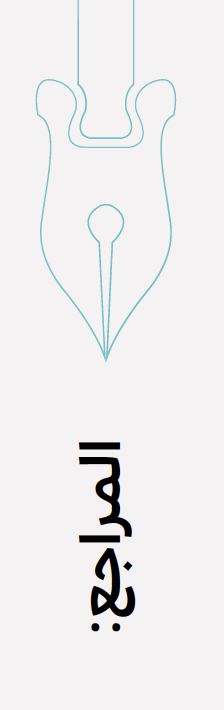
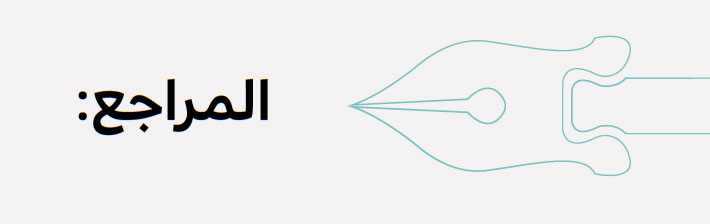
- أحمد حلمي مصطفى، الغرفة النبوية الشريفة (القاهرة: دار الجمهورية للصحافة، 2015م).
- طلال الطريفي، العثمانيون: التاريخ الممنوع (الرياض: دار ائتلاف، 2020).
- محمد الساعد، سفربرلك (الرياض: دار مدارك، 2019).
