
السرقة المقدسة:
الجريمة العثمانية المكررة في التاريخ الحديث
يُقدَّم السلطان العثماني سليمان القانوني في الذاكرة الرسمية التركية على أنه باني الحرمين ومجددهما، لكن التدقيق في الأحداث يكشف وجهًا آخر من ممارساته: سرقة أجزاء من ما الحجر الأسود، وتحويلها إلى أدوات لتلميع صورته السلطانية وإشباع نزعة التقديس الذاتي.
كيف حوّل سليمان القانوني أقدس رموز الكعبة إلى أدوات شخصية لتقديس ذاته وترسيخ سلطانه؟.

الحجر الأسود، يُعدُّ من الأشياء المُقدَّسَّة التي لا يمكن المساس بها أو توظيفها لأشياء شخصية. لكن حين تضررت الكعبة وتفتت بعض أجزاء الحجر الأسود، لم يتجه القانوني لحفظها في مكانها الطبيعي وإعادتها، بل أمر بنقلها إلى إسطنبول. وما أُطلق عليه “حفظ للأمانة” لم يكن سوى استيلاء ممنهج على رمز مقدس، انتهى بأن أصبح جزءًا من ديكور السلطان الشخصي؛ فقد وُضع أكبر جزء من الحجر عند مدخل ضريحه في مجمع السليمانية، بينما وُزّعت قطع أخرى في مسجد صوقوللو محمد باشا لتصبح جزءًا من زينة المحراب والمنبر.
هنا يتضح أن القضية ليست مجرد ترميم أو “حرص” كما يحلو للمؤرخين العثمانيين المعاصرين أن يصوروا، بل هي استغلال صريح لقدسية الحجر في خدمة سلطة فرد واحد. فالسلطان لم يحتفظ به لمصلحةٍ عامَّة، بل جعله شاهدًا على قبره، كأنه يربط ذاته بتاريخ الإسلام ويمتزج اسمه بالحجر المقدس ليُضفي على شخصه مسحة من العصمة والتقديس.
إنها ممارسة لا تقل جرمًا عن حادثة القرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود عام (929م)، الفرق الوحيد أن العباسيين استعادوه منهم بعد مفاوضات وأموال، بينما العثمانيون أباحوا لأنفسهم احتكاره من قرون دون وجه حق. والأنكى أن يُقدَّم ذلك على أنه “خدمة للحرمين”، بينما الحقيقة أنه كان شكلًا من أشكال السطو الرمزي على قدسية الكعبة ونقلها إلى حضرة السلطان.
ومما يبدو أن السرقة عادة عثمانية، فالأمانات التي نُهبت لاحقًا عبر “قطار الأمانات المقدسة” عام (1917) لم تكن إلا استكمالًا لنهج السرقة ذاته. عدد كبير من القطع النفيسة، من المصاحف والمجوهرات والسيوف والهدايا التي تراكمت في الحجرة النبوية عبر قرون، جُمعت وسُيّرت إلى إسطنبول باعتبارها “أمانات”. لكن أي أمانة هذه التي تُنتزع من مكانها الطبيعي، وتُعرض كغنائم في متاحف أو مساجد عثمانية؟ إن التسمية ذاتها تكشف الخديعة: فـ”الأمانة” تعني وديعة تُحفظ لصاحبها، لا أن تُساق قسرًا إلى ملكية دولة وسلاطين.
لقد كان الحجر أيضًا ضحية لهذا التعدي. وُضع جزء منه في مسجد أدرنة، بينما لم يجرؤ المؤرخون الرسميون على الإفصاح الكامل عما نُقل وما لم يُكشف بعد. وهو ما يعزز فرضية أن ما جرى لم يكن مجرد “حفظ”، بل استغلال متعمد للرموز الدينية كوسيلة لإبراز عظمة السلطان وشخصيته “الجامعة”.
إن سردية “الحرص العثماني على الحرمين” تنهار أمام هذه الوقائع. فلو كان المقصد الحفاظ، لكان الأولى ترك الحجر في مكانه أو حفظه في مؤسسات عامة. أما أن يُوزّع بين ضريح السلطان ومساجد أنصاره، فذلك يفضح جوهر النية: تحويل الأثر المقدس إلى شهادة أبدية على “عظمة” القانوني وربط اسمه بقداسة الكعبة ذاتها.
لقد استغل العثمانيون الحجر الأسود لأغراض شخصية وسياسية، فجعلوه وسيلة لشرعنة حكمهم وإضفاء هالة روحية على سلطانهم. إنها جريمة موصوفة بحق قدسية الحرمين، لا تقل عن جريمة القرامطة في وحشيتها الرمزية، بل تفوقها خطورة لأنها غُلِّفت بلباس “الخدمة والحرص”، فبدت أمام العامة كفضيلة وهي في حقيقتها سرقة مموهة.
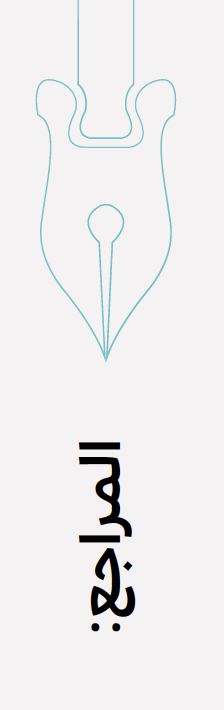
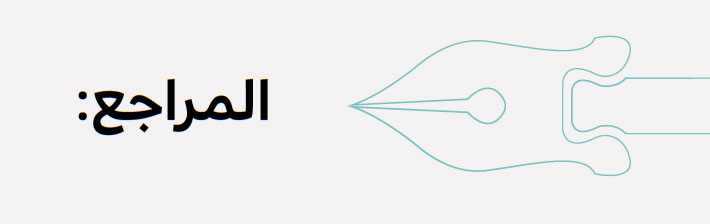
- أبو بكر بن عبد الله الدواداري، كنز الدرر وجامع الغرر، المحققون: بيرند راتكه (القاهرة: عيسى البابي، 1982).
- أيوب صبري باشا، موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب (القاهرة: دار الآفاق العربية، 2004).
- ثريا فاروقي، حجاج وسلاطين “الحج أيام العثمانيين”، ترجمة: أبو بكر باقادر (بيروت: منشورات الجمل، 2010).
- عبدالقادر الأنصاري، الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة (الرياض: دار اليمامة للنشر، د.ت).
